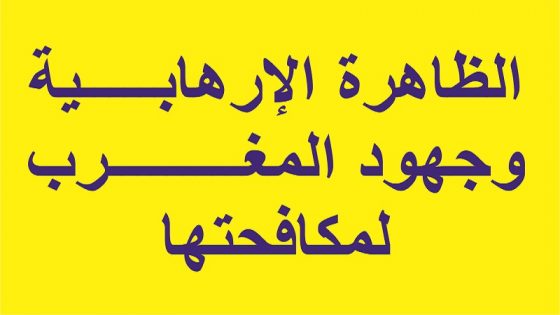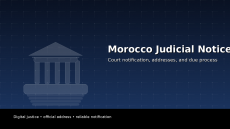مقــــدمــة:
تعد الأهلية الانتخابية إحدى الدعائم الجوهرية التي يقوم عليها النظام الديمقراطي، فهي المعيار الذي تتجسد من خلاله الإرادة الشعبية في اختيار ممثلي الأمة، والآلية التي تُمكِّن المواطن من الاضطلاع بدوره في الحياة العامة، بما يحقق مبدأ المشاركة السياسية ويعزز الشرعية الدستورية للمؤسسات المنتخبة. غير أنّ هذه الأهلية، وإن كانت حقا أصيلا مكرسا دستوريا، فإنها لا تمارس على إطلاقها، بل قد تتعرض للتقييد أو الحرمان كأثر من آثار الحكم الجنائي، إذ إن ارتكاب الجرائم يعدّ مساسا بالثقة العامة وإخلالاً بالاعتبار اللازم لممارسة الحقوق السياسية.
وفي مواجهة هذا الأثر المانع، عمل المشرع المغربي، على غرار التشريعات المقارنة، على إرساء مؤسسات قانونية ذات طابع استثنائي، تروم التخفيف من حدة العقوبة وتمكين المحكوم عليهم من استعادة مكانتهم القانونية والاجتماعية، ومن ثمة إعادة إدماجهم في النسيج المجتمعي، ومن أبرز هذه المؤسسات مؤسسة رد الاعتبار بنوعيه، القانوني الذي يتحقق بقوة القانون بعد انصرام آجال محددة، والقضائي الذي يتوقف على صدور حكم من القضاء المختص، وهي مؤسسة يترتب عنها محو الحكم وآثاره واستعادة الحقوق المهدورة وفي مقدمتها الأهلية الانتخابية. وإلى جانبها، يبرز العفو الملكي باعتباره مظهرا من مظاهر السمو الدستوري للملكية، يمارس في إطار الصلاحيات المقررة لجلالة الملك، فيتحقق به إسقاط العقوبة أو استبدالها أو تخفيفها، غير أنّ طبيعته الاستثنائيةشا وخصائصه المميزة تثير نقاشاً حول حدوده القانونية وآثاره على الحقوق السياسية، ولاسيما استرجاع الأهلية الانتخابية.
وإذا كان رد الاعتبار، بحكم طبيعته القانونية والقضائية، يحدث محوا تاما للعقوبة وآثارها، فإن العفو الملكي، باعتباره إجراء ساميا ينصرف في الغالب إلى العقوبة ذاتها دون المساس بالواقعة الإجرامية أو الحكم الصادر بشأنها، يطرح تساؤلاً مشروعاً حول نطاقه، هل يمتد أثره ليشمل محو الحرمان من الحقوق السياسية وبالتالي إعادة الأهلية الانتخابية للمستفيد منه؟، أم يظل مقتصرا على رفع العقوبة أو تخفيفها دون المساس بما ترتب عنها من آثار تبعية؟ وهل يمكن لهذين الاجرائين أن يعيدا للمحكوم عليهم حقوقهم السياسية ويمنعان سقوط الأهلية الانتخابية؟، أم أن القانون المغربي يعتبر فقدان الأهلية الانتخابية مستقلا عنهما؟
إن هذه الإشكالية تكشف عن تداخل معقد بين نظامين قانونيين مختلفين في الأساس والغاية، أحدهما ذو طابع قضائي وقانوني صرف يتمثل في رد الاعتبار، والآخر ذو طبيعة دستورية وسياسية استثنائية يتمثل في العفو الملكي. وهو تداخل يستدعي الوقوف على مدى تقاطعهما أو تباينهما في مجال استرجاع الأهلية الانتخابية، خاصة وأن هذه الأخيرة ترتبط ارتباطا وثيقا بمبدأ المواطنة وبالممارسة الديمقراطية، مما يجعل أي مساس بها أو استرجاع لها يكتسي بعداً يتجاوز الفرد إلى المجتمع ككل.
وتبرز أهمية هذا الموضوع في كونه يلامس جوهر الحقوق السياسية ويطرح إشكاليات دقيقة تتعلق بمدى انسجام التشريع الوطني مع المبادئ الدستورية ومع التوجهات الحقوقية الكونية، كما أنه يثير تساؤلات عملية ترتبط بالتطبيق القضائي وبالتدبير السياسي لمؤسسة العفو. ومن ثمة، فإن البحث في الآثار القانونية المترتبة عن كل من رد الاعتبار والعفو الملكي على استرجاع الأهلية الانتخابية، ليس مجرد دراسة تقنية، بل هو مقاربة تسعى إلى التوفيق بين فلسفة العقوبة وإعادة الإدماج، وبين متطلبات حماية النظام العام وضمان الحقوق الدستورية للأفراد، في أفق تكريس دولة الحق والقانون وتعزيز الثقة في النظام الانتخابي.
ومن خلال هذا المقال سنحاول التطرق إلى تحليل هذه الإشكالية من خلال دراسة النصوص القانونية المنظمة للأهلية الانتخابية، واستعراض الاجتهادات القضائية المغربية في الموضوع، مع التركيز على أثر العفو الملكي ورد الاعتبار على استرجاع الأهلية الانتخابية.
الفقرة الأولى: الإطار القانوني لفقدان الأهلية الانتخابية
إن الحق في المشاركة السياسية، باعتباره أحد الحقوق الدستورية الأساسية، يجد مصدره في الفصل 30 من دستور المملكة لسنة 2011 الذي نص صراحة على أن للمواطنين والمواطنات البالغين سن الرشد المدني الحق في التصويت والترشح للانتخابات، غير أنّ المشرع الدستوري، ورغم تكريسه لهذا الحق، لم يطلقه على إطلاقه، بل قيده بمقتضى عبارة دقيقة مفادها أن القانون هو الذي يحدد شروط ممارسة هذه الحقوق، وهو ما يعني أن المشرع العادي مُفوّض دستوريا لإقرار ضوابط موضوعية وشكلية تحدد نطاق ممارسة الحق الانتخابي، وتبين الحالات التي قد يُحرم فيها المواطن من هذا الحق سواء بصفة مؤقتة أو نهائية. وفي هذا الإطار يبرز نظام فقدان الأهلية الانتخابية باعتباره مؤسسة قانونية غايتها ضبط الممارسة الانتخابية وحمايتها من كل ما من شأنه المساس بصدقيتها ونزاهتها، إذ إن المشاركة في الانتخابات، سواء بالتصويت أو بالترشح، تفترض توفر شروط قانونية محددة في الناخب أو المترشح، وعدم تحقق هذه الشروط يؤدي قانونا إلى فقدان الأهلية الانتخابية.
ويجد هذا النظام سنده المباشر في القوانين الجنائية والتنظيمية المؤطرة للانتخابات، فالقانون الجنائي المغربي نص في الفصل 26 على أن العقوبات التكميلية تشمل الحرمان من ممارسة بعض الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية، وهو ما يمتد ليشمل الحقوق السياسية، وفي مقدمتها الحق في التصويت والترشح. كما نص الفصل 36 على حالات الحرمان من الحقوق الوطنية والسياسية، محددا نطاقها ومفعولها القانوني. وهو ما يعني أن صدور حكم قضائي بالإدانة في جناية أو جنحة خطيرة يمكن أن يترتب عنه بحكم القانون فقدان الأهلية الانتخابية، إما بصفة مؤقتة خلال فترة تنفيذ العقوبة أو بصفة دائمة إذا نص الحكم على ذلك. ويضاف إلى ذلك ما ورد في القوانين التنظيمية الثلاثة المتعلقة بمجلس النواب (القانون التنظيمي رقم 27.11) ومجلس المستشارين (القانون التنظيمي رقم 28.11) وانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية (القانون التنظيمي رقم 59.11)، حيث تضمنت كلها مقتضيات صريحة تمنع تسجيل المترشحين الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية تقضي بفقدان الأهلية الانتخابية، كما تقضي بفقدان الصفة الانتخابية لمن تبين لاحقًا أنه غير مستوف للشروط القانونية، أمّا القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة فقد اشترط بدوره، من أجل التسجيل، عدم صدور أي حكم قضائي بالحرمان من الحقوق الانتخابية، مما يبين أن فقدان الأهلية لا يقتصر على الترشح فقط بل يشمل حتى التسجيل في اللوائح ومباشرة الحق في التصويت.
ويتخذ فقدان الأهلية الانتخابية صورًا متعددة؛ فقد يكون فقدانًا بقوة القانون كما هو الحال بالنسبة للقاصرين الذين لم يبلغوا سن الرشد المدني، أو المحجور عليهم قضائيًا بسبب عجز عقلي أو سلوك منحرف، أو الأشخاص المحكوم عليهم بأحكام جنائية سالبة للحرية، إذ لا يخول لهم القانون ممارسة حقوقهم السياسية خلال فترة تنفيذ العقوبة. كما قد يكون فقدان الأهلية بموجب حكم قضائي، عندما تقضي المحكمة بعقوبة إضافية أو تبعية تتمثل في الحرمان من الحقوق السياسية، وهو ما يترتب آثاره تلقائيًا على أهلية الشخص الانتخابية. وقد يكون الفقدان مؤقتًا ينتهي بانقضاء المدة أو بزوال السبب، كما في حالة انتهاء العقوبة أو استرجاع الأهلية بحكم قضائي لاحق، وقد يكون نهائيًا في حالات استثنائية نص عليها القانون، خاصة إذا تعلق الأمر بجرائم خطيرة تمس بالثقة العامة أو الأمن الداخلي للدولة.
ورغم أن فقدان الأهلية الانتخابية يشكل في جوهره قيدًا على ممارسة حق دستوري، فإن المشرع أرفقه بجملة من الضمانات الأساسية تحقيقًا لمبدأ الشرعية وحماية للحقوق الفردية، إذ لا يمكن إقرار هذا الفقدان إلا بنص صريح يحدد حالاته وضوابطه، كما لا يمكن الحكم به إلا بناء على مقرر قضائي نهائي صادر عن محكمة مختصة، مع قابلية هذا المقرر للطعن وفق المساطر القانونية، وهو ما يجسد مبدأ القضائية باعتباره ضمانة أساسية ضد أي تعسف محتمل. كما أن الأصل في فقدان الأهلية أنه مؤقت، بحيث لا يُصار إلى الحرمان النهائي إلا في حالات محدودة وبالقدر اللازم لحماية النظام العام، وهو ما يعكس احترام المشرع لمبدأ التناسب بين الغاية (حماية نزاهة الانتخابات) والوسيلة (حرمان بعض الأشخاص من المشاركة). فضلا عن ذلك، يخضع جميع المواطنين لنفس المقتضيات القانونية دون أي استثناء أو تمييز، تكريسًا لمبدأ المساواة أمام القانون.
غير أن مؤسسة فقدان الأهلية الانتخابية، رغم تأصيلها الدستوري والتنظيمي، تثير نقاشًا فقهيًا وحقوقيًا مهمًا، إذ يعتبرها البعض ضرورة لضمان نزاهة العملية الانتخابية وصونها من أي انحراف أو اختراق، لاسيما في مجتمع ديمقراطي ناشئ يسعى لترسيخ ثقة المواطن في مؤسساته، في حين يرى فيها البعض الآخر مساسًا جوهريًا بالحقوق السياسية للمواطنين قد يتحول إلى وسيلة لإقصاء فئات بعينها من الحقل السياسي، خصوصًا إذا لم تُضبط معاييرها بدقة أو إذا أسيء استعمالها. وبين هذين الموقفين يبقى المشرع المغربي مدعوًا إلى الموازنة الدقيقة بين حماية نزاهة العملية الانتخابية وضمان أوسع مشاركة ممكنة في الحياة السياسية، وهو توازن يتطلب ترشيد حالات فقدان الأهلية وتقييدها في أضيق نطاق، بما ينسجم مع المعايير الدستورية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها المملكة، لاسيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وعليه، فإن الإطار القانوني والتنظيمي لفقدان الأهلية الانتخابية في المغرب يشكل منظومة متكاملة تستمد مشروعيتها من الدستور وتستند في تفاصيلها إلى نصوص قانونية متفرقة، سواء في القانون الجنائي أو في القوانين التنظيمية المؤطرة للانتخابات أو في القانون الخاص باللوائح الانتخابية، وكلها تلتقي عند غاية واحدة تتمثل في حماية الشرعية الديمقراطية وصون العملية الانتخابية من كل ما قد يخل بمصداقيتها. غير أن هذه المنظومة، ورغم أهميتها، تظل مجالًا مفتوحًا للمراجعة والتطوير بما يحقق الانسجام بين متطلبات الشرعية الدستورية والتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، ويضمن في الوقت نفسه تفعيل المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة في أفق تعزيز المسار الديمقراطي للمملكة
الفقرة الثانية: الاجتهادات القضائية المغربية في تفسير فقدان الأهلية الانتخابية
لقد شكل موضوع فقدان الأهلية الانتخابية أحد المواضيع المحورية التي شغلت الاجتهاد القضائي المغربي، وذلك بالنظر إلى ما له من انعكاس مباشر على سلامة العملية الانتخابية، وحماية المؤسسات التمثيلية من كل شائبة قد تمس بشرعيتها أو نزاهتها. فالأهلية، باعتبارها شرطاً لازماً لممارسة الحقوق السياسية، تندرج ضمن الضمانات الجوهرية التي لا غنى عنها لتأهيل المواطن لولوج المهام الانتدابية والنيابية، ومن ثم فإن فقدانها لا يعد مجرد مسألة شكلية أو إجرائية، وإنما قاعدة آمرة ذات طبيعة موضوعية ترمي إلى حماية المصلحة العامة وضمان استمرارية المؤسسات الدستورية على أسس من المشروعية والشفافية.
وقد انبرى القضاء المغربي، بمختلف درجاته، لتفسير وتطبيق النصوص القانونية المنظمة لفقدان الأهلية الانتخابية، سواء تعلق الأمر بالمحاكم الإدارية باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل في المادة الانتخابية، أو بمحكمة النقض في إطار رقابتها على سلامة التعليل القانوني للأحكام، أو بالمجلس الدستوري (سابقاً) والمحكمة الدستورية (حالياً) في نطاق الرقابة على دستورية القوانين والفصل في النزاعات الانتخابية البرلمانية.
ففي هذا السياق، أكدت المحكمة الإدارية بالرباط في حكمها عدد 1206 بتاريخ 19 يونيو 2015 أن فقدان الأهلية الانتخابية يرتب بقوة القانون سقوط العضوية، وأن القرار الذي يتخذه عامل العمالة أو الإقليم لا يعدو أن يكون إجراءً كاشفاً لوضع قانوني سابق، لا منشئاً له. وهو تعليل بالغ الدلالة، إذ يبين أن المشرع جعل فقدان الأهلية أثراً قانونياً مباشراً، ينشأ بمجرد تحقق سببه، دون حاجة إلى تدخل إداري أو قضائي لإقراره. فالقرار الإداري هنا له طبيعة “إعلامية” لا “إنشائية”، وهو ما ينسجم مع القواعد العامة في القانون الإداري التي تميز بين القرارات الكاشفة والقرارات المنشئة.
كما أيدت محكمة النقض هذا الاتجاه في قرارها عدد 1390 بتاريخ 22 دجنبر 2011 (ملف إداري عدد 2011/1/4/521) حين اعتبرت أن شرط الأهلية شرط جوهري لاستمرار العضوية الانتخابية، وأن فقدانه يؤدي إلى بطلان الانتداب بقوة القانون، بما يعني أن العضوية تسقط تلقائياً دون حاجة إلى مسطرة معقدة أو قرار إنشائي. وتكمن أهمية هذا القرار في أنه ربط بين الأهلية كشرط سابق للترشح، واستمراريتها كشرط لاحق لممارسة الانتداب، مؤكداً بذلك على الطبيعة “المستمرة” لشرط الأهلية.
أما المجلس الدستوري، فقد أبرز في قراره رقم 850/2012 أن حرمان المحكوم عليهم قضائياً من الأهلية الانتخابية لا يشكل مساساً بالحقوق الدستورية المكفولة للمواطنين، بل يعد إجراءً وقائياً مشروعاً يرمي إلى حماية نزاهة العملية الانتخابية وضمان استقلالية المؤسسات المنتخبة. واستند في ذلك إلى كون الدستور نفسه قد أحال على القانون العادي تحديد شروط الترشح والأهلية، بما يتيح للمشرع أن يضع قيوداً معقولة ومبررة تستهدف المصلحة العامة. ويعكس هذا التوجه التوازن الذي يقيمه القضاء الدستوري بين الحقوق الفردية من جهة، ومتطلبات الشفافية والنزاهة في الحياة العامة من جهة أخرى.
ولم يقف الاجتهاد القضائي عند هذا الحد، بل واصل ترسيخ مبادئ أخرى تؤكد الطبيعة الآمرة لفقدان الأهلية الانتخابية. فقد اعتبرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في حكمها عدد 345 بتاريخ 7 أبريل 2016 (ملف عدد 2016/7107/45) أن فقدان الأهلية لا يقبل أي تبرير أو استثناء، باعتباره من النظام العام الانتخابي، وأن الطعن في قرار إثباته لا يمكن أن يقوم على مجرد اعتبارات شكلية، بل ينبغي أن ينصب على تحقق السبب القانوني المؤدي إلى فقدانها. ومن خلال هذا التعليل، يظهر بجلاء أن القضاء يعتبر الأهلية الانتخابية شرطاً “نظامياً” يعلو على إرادة الأطراف والإدارة على السواء.
كما قضت المحكمة الدستورية في قرارها رقم 18/17 بتاريخ 8 غشت 2017، المتعلق بنزاع حول انتخاب أعضاء مجلس النواب، بأن فقدان الأهلية الانتخابية بسبب صدور حكم قضائي نهائي بالحرمان منها، يترتب عليه حتماً تجريد المعني بالأمر من العضوية، دون أن يكون للمحكمة مجال لتقدير الملاءمة. فالجزاء هنا آلي وذو طبيعة موضوعية، لا يترك للقاضي سلطة تقديرية سوى في التحقق من ثبوت سببه.
ومن جانب آخر، عززت محكمة النقض هذا التوجه في قرارها عدد 223 بتاريخ 3 مارس 2020 (ملف إداري عدد 2019/1/4/650)، إذ اعتبرت أن احترام شرط الأهلية الانتخابية يدخل ضمن “الضمانات الجوهرية للنظام الديمقراطي”، وأن القضاء الإداري حينما يقضي ببطلان الانتخاب بسبب فقدان الأهلية، فإنه يطبق قاعدة دستورية لا مجرد نص تشريعي. وهذا التعليل يرفع شرط الأهلية إلى مصاف القواعد الدستورية، ويضفي على فقدانها طابعاً فوق قانوني.
ومن خلال تتبع هذه الأحكام والقرارات، يمكن استخلاص مجموعة من المبادئ القضائية المستقرة، وهي:
– أن الأهلية الانتخابية شرط مستمر، يمتد أثره من لحظة الترشح إلى غاية انتهاء الانتداب.
– أن فقدان الأهلية يترتب بقوة القانون وبأثر تلقائي، دون حاجة إلى تدخل إداري أو قضائي منشئ.
– أن القرار الإداري أو القضائي الذي يثبت فقدان الأهلية له طبيعة كاشفة فقط.
– أن فقدان الأهلية يدخل في نطاق النظام العام، فلا يقبل التنازل عنه أو الاتفاق على مخالفته.
– أن القضاء الدستوري يوازن بين حماية الحقوق الفردية وضمان نزاهة المؤسسات، مرجحاً في النهاية كفة المصلحة العامة.
وبناءً على ما سبق، يتضح أن الاجتهاد القضائي المغربي قد ساهم في بناء نظرية متكاملة لفقدان الأهلية الانتخابية، قائمة على اعتباره قاعدة آمرة لحماية المشروعية الدستورية والشفافية الديمقراطية، مما يجعل فقدانها أثراً حتمياً يترتب بمجرد تحقق سببه، ويجرد كل محاولة للالتفاف حولها من أي قيمة قانونية.
الفقرة الثالثة: العفو الملكي ورد الاعتبار وأثرهما على الأهلية الانتخابية
يثير العفو الملكي ورد الاعتبار إشكالية واضحة بالنسبة لاستعادة الحقوق السياسية للأفراد المحكوم عليهم. فالعفو الملكي، رغم أنه يسقط العقوبة أو يخففها، فإنه لا يعيد تلقائيًا الأهلية الانتخابية، ما لم ينص القانون صراحة على خلاف ذلك، وقد أكدت محكمة النقض هذا التوجه في قرارها عدد 411/1 بتاريخ 28 أبريل 2016 (ملف إداري عدد 3683/4/1/2014)، معتبرة أن العفو الملكي يرتب آثارًا جنائية فقط، ولا يؤثر في فقدان الأهلية الانتخابية.
أما رد الاعتبار، سواء كان قضائيًا أو قانونيًا، فإنه يهدف إلى محو الآثار الجنائية للعقوبة، لكنه لا يمتد إلى الحقوق السياسية، أي أن فقدان الأهلية يبقى قائمًا رغم صدور حكم برد الاعتبار، وقد أكدت محكمة النقض في حكمها عدد 217/2014 أن رد الاعتبار لا يعيد الحقوق السياسية إلا إذا نص القانون صراحة على استرجاعها.
وفي هذا السياق، استقر اجتهاد محكمة النقض على أن فقدان الأهلية الانتخابية يترتب بقوة القانون بمجرد صدور حكم نهائي بالإدانة في جرائم أو جنح معينة، بصرف النظر عن العفو أو رد الاعتبار.
ففي القرار عدد 551/2022 اعتبرت المحكمة أن إدانة المترشح من أجل جنحة الإرشاء بعقوبة سالبة للحرية كافية لفقدانه أهليته الانتخابية بتاريخ الاقتراع، وهو نفس التوجه الذي أكده القرار عدد 1617/2022، حيث خلص إلى أن الحكم الصادر في مواجهة المترشح من أجل إصدار شيك بدون مؤونة يجرده من شرط الأهلية الانتخابية المنصوص عليها في المادة 7 من القانون التنظيمي رقم 57.11. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل رسخت المحكمة بمقتضى القرار عدد 47/2022 قاعدة مفادها أن العقوبات الانتخابية تترتب بقوة القانون عن بعض الجرائم المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 59.11، وتؤدي إلى الحرمان من حق الترشح لفترتين انتخابيتين متتاليتين ابتداءً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً.
ومن جهة أخرى، أبرز القرار عدد 6373/2021 أن رد الاعتبار، وإن كان يعيد للمحكوم عليه بعض حقوقه وفق قانون المسطرة الجنائية، فإنه لا يسترجع به الأهلية الانتخابية، لأن النصوص الانتخابية تُعد نصوصاً خاصة مقدمة في التطبيق على النصوص العامة، وهو ما أعاده القرار عدد 5826/2021 بالتأكيد، حينما شدد على أن العفو الملكي الخاص لا يُنتج بذاته استرجاع الأهلية الانتخابية بالنسبة للمحكوم عليهم بعقوبة جنائية، مادام القانون التنظيمي لم يورد ذلك ضمن حالات استرداد الأهلية، وفي نفس الاتجاه سار القرار عدد 2879/2019 حين اعتبر أن المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، سواء نافذة أو موقوفة التنفيذ لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر، لا يمكنهم القيد في اللوائح الانتخابية ولا اكتساب صفة ناخب تؤهلهم للترشح.
وقد استحضرت محكمة النقض في القرار عدد 359/2016 أن المشرع الانتخابي استحدث، في إطار تخليق الحياة العامة، نظاماً خاصاً للأهلية، بما يجعلها تختلف عن النظام العام المقرر في القوانين الأخرى. بل إن القرار عدد 1327/2002 اعتبر أن فقدان الأهلية الانتخابية من شأنه أن يؤدي إلى بطلان العملية الانتخابية إذا أثّر على نتائجها. كما قضت المحكمة في القرار عدد 429/2016 بأن مجرد حصول المترشح على عفو ملكي شامل لا يكفي لاستعادة أهليته الانتخابية، خاصة إذا لم يتم التمسك به أمام محكمة الموضوع، مما يعكس الطبيعة الاستثنائية لنظام العفو في المجال الانتخابي.
وباستقراء هذه الاجتهادات، يتضح أن القضاء المغربي قد حسم في التمييز بين الأثر الجنائي للعفو ورد الاعتبار، وبين أثرهما في المجال الانتخابي، حيث إن هذا الأخير يبقى محكوما بمقتضيات خاصة صارمة تكرس مبدأ تخليق الحياة السياسية وحماية مصداقية المؤسسات التمثيلية، بما يحقق الانسجام مع المقتضيات الدستورية المؤطرة للعملية الانتخابية.
الفقرة الرابعة: أثر العقوبة الموقوفة التنفيذ على الأهلية الانتخابية
تثير العقوبات الموقوفة التنفيذ جدلًا حول إمكانية استمرار الأهلية الانتخابية، غير أن القانون التنظيمي رقم 57-11 واضح في هذا الصدد، إذ اعتبر فقدان الأهلية قائمًا حتى بالنسبة للعقوبات الموقوفة التنفيذ، شريطة أن تتجاوز مدة ستة أشهر، ويستفاد أن المشرع ربط فقدان الأهلية بصدور الحكم النهائي لا بتنفيذه الفعلي.
وقد دعم القضاء هذا التوجه، إذ قضت محكمة النقض في حكمها عدد 411/1 بتاريخ 28 أبريل 2016 أن العقوبة الموقوفة التنفيذ كافية لإحداث الحرمان الانتخابي، مؤكدة أن وقف التنفيذ لا يمنع تطبيق المادة 7 من القانون التنظيمي رقم 57-11. كما أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط في حكمها عدد 1509/2015 قرارًا مماثلًا، معتبرة أن أي محاولة لاستغلال وقف التنفيذ لإعادة الأهلية الانتخابية تُعد مخالفة صريحة للنظام العام الانتخابي.
ويستفاد من هذا التفسير أن المشرع والقضاء يهدفان إلى حماية العملية الانتخابية من أي تأثير سلبي للأحكام الجنائية، وضمان أن جميع الأعضاء والناخبين يتمتعون بسجل قضائي نظيف، بما يضمن نزاهة المؤسسات المنتخبة، ويمنع أي تلاعب بإعادة الأشخاص المحكوم عليهم إلى ممارسة حقوقهم السياسية قبل انتهاء المدة القانونية، و من هنا يتضح أن فقدان الأهلية الانتخابية في القانون المغربي لا يستعاد تلقائيا عن طريق العفو الملكي أو رد الاعتبار، إذ يظل مرتبطًا بصدور الحكم النهائي بالعقوبة السالبة للحرية، سواء كانت نافذة أو موقوفة التنفيذ، وقد أكدت الاجتهادات القضائية المغربية هذا التوجه، سواء من خلال أحكام محكمة النقض، أو المحكمة الإدارية، أو المجلس الدستوري، بما يعكس حرص القانون على حماية نزاهة العملية الانتخابية وضمان مصداقية التمثيل السياسي.