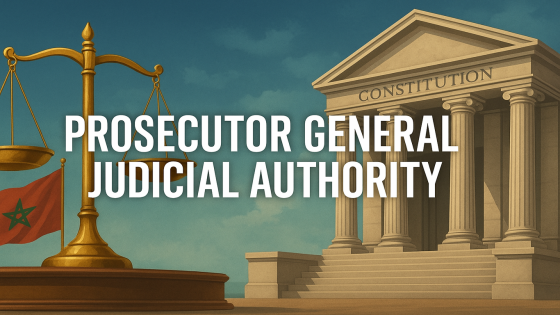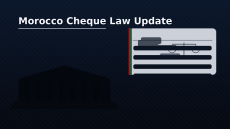تطرحُ قراءة القرار الدستوري رقم 255/25 الصادر عن المحكمة الدستورية بتاريخ 4 غشت 2025 سؤالًا مركزيًا حول موقع وسلطة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسًا للنيابة العامة، داخل هندسة السلطة القضائية بالمغرب. فبينما أسقط القرار عددًا من المقتضيات المرتبطة بمشروع قانون المسطرة المدنية رقم 23.02، فإنه في المقابل أعاد ترتيب الأدوار بين الفاعلين: الوزير المكلف بالعدل، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، وأضاء بشكل لافت على الدور الخاص للوكيل العام للملك باعتباره فاعلًا قضائيًا لا إداريًا، وحارسًا لـ“حسن سير الدعوى” وحماية النظام العام.
أولًا: الإطار الدستوري والمؤسساتي لسلطة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض
يشكل دستور 2011 نقطة الانطلاق لفهم مكانة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض؛ إذ كرّس مبدأ استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأرسى فصلًا واضحًا بين القضاء والحكومة، مع الإقرار بأن قضاة النيابة العامة يلتزمون بتطبيق القانون وبالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها.
في هذا السياق، حدّد القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة أن قضاة النيابة العامة يُوضَعون “تحت سلطة وإشراف ومراقبة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورؤسائهم التسلسليين”. هذا المقتضى لا يمنح الوكيل العام سلطة شكلية فحسب، بل يجعل منه قمة الهرم في البنية الهرمية للنيابة العامة، ومسؤولًا عن توحيد سياستها الجنائية وضمان انسجام عملها على امتداد التراب الوطني.
وزاد القانون رقم 33.17 في تدعيم هذا المركز حين نقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، المتعلقة بالإشراف على النيابة العامة، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسًا للنيابة العامة. وبموجب هذا القانون، حلّ الوكيل العام محل وزير العدل في الاختصاصات المتصلة بتتبع سير قضايا النيابة العامة، وتوجيه التعليمات العامة والفردية، وتقييم عمل أعضائها.
هذا التحول المعياري جعل من الوكيل العام فاعلًا مركزيًا في معادلة استقلال القضاء: فهو قاضٍ يمارس وظيفة قضائية (رئاسة النيابة العامة)، وفي نفس الوقت يضطلع بدور مؤسساتي استراتيجي في رسم السياسة الجنائية وتنسيق عمل النيابات العامة، دون خضوع للسلطة التنفيذية. وهو ما تؤكده أيضًا النصوص الرسمية لرئاسة النيابة العامة التي تبرز دورها في حماية النظام العام والحقوق والحريات، من خلال ترشيد استعمال سلطة المتابعة وترسيخ شرعية تدخلات النيابة العامة في علاقاتها بالمجتمع.
ثانيًا: حضور الوكيل العام في مشروع قانون المسطرة المدنية رقم 23.02
حينما أحالت الحكومة على المحكمة الدستورية مشروع قانون المسطرة المدنية رقم 23.02 قبل صدوره، كان من بين النقاط المثيرة للجدل تلك المتعلقة بأدوار النيابة العامة بصفة عامة، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفة خاصة، في بعض المساطر ذات الحساسية العالية.
من بين هذه المقتضيات المادة 17 التي خولت “للنيابة العامة المختصة” طلب التصريح ببطلان كل مقرر قضائي مخالف للنظام العام داخل أجل خمس سنوات من صيرورته حائزًا لقوة الشيء المقضي به. ورغم أن النص لم يخصص الوكيل العام لدى محكمة النقض، إلا أنه يعكس فلسفة توسع في أدوار النيابة العامة كحارس للنظام العام القضائي. غير أن المحكمة الدستورية رأت أن هذه الصياغة، لكونها عامة ومجردة وتفتقر إلى تحديد دقيق للحالات والضوابط، تمس بالأمن القضائي وباستقرار الأحكام النهائية، وقضت بعدم دستوريتها.
أما المادتان 408 و410 فهما الأكثر ارتباطًا مباشرة بمركز الوكيل العام. فقد أسندتا، في صيغتهما الأولى، لكلٍّ من وزير العدل والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض صلاحية تقديم طلبات الإحالة إلى هذه المحكمة في حالتي: تجاوز القضاة لسلطاتهم، أو وجود تشكك مشروع في حيادهم. وهنا جاءت التفرقة الحاسمة في القرار 255/25:
• اعتبرت المحكمة أن تخويل وزير العدل، وهو عضو في السلطة التنفيذية، سلطة التدخل في مسار الدعوى عبر آلية الإحالة، يتعارض مع استقلال السلطة القضائية.
• في المقابل، أقرت بدستورية تدخل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، باعتباره جزءًا من السلطة القضائية ورئيسًا للنيابة العامة، ومسؤولًا عن حسن سير الدعوى وحماية النظام العام.
بهذا المعنى، لم يكتف القرار برفض امتداد يد السلطة التنفيذية إلى قلب العملية القضائية، بل أعاد التأكيد على أن أي تدخل في مسار الدعوى لا يكون مشروعًا إلا إذا كان صادرًا عن فاعل قضائي أصيل، وعلى رأسهم الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض في هذه الحالة.
ثالثًا: تعليل المحكمة الدستورية لمركز الوكيل العام كفاعل قضائي لا إداري
أهمية القرار 255/25 لا تكمن فقط في النتيجة (عدم دستورية بعض المواد) بل في التعليل الذي قدّمته المحكمة الدستورية. ففي معرض حديثها عن المواد 408 و410، استندت المحكمة إلى:
• الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، التي تقرر أن السلطة القضائية تُمارَس من قبل القضاة المزاولين فعليًا لمهامهم القضائية بمحاكم المملكة.
• المادة 25 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، التي تنص على وضع قضاة النيابة العامة تحت سلطة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.
وانتهت المحكمة إلى نتيجة مفادها أن الاختصاصات المتعلقة بحسن سير الدعوى في مجال المسطرة المدنية يجب أن تُسند حصريًا لمن يمارس السلطة القضائية، وليس لمن يمارس السلطة التنفيذية. ومن ثَمَّ، فإن إحالة القضايا إلى محكمة النقض بسبب تجاوز القضاة لصلاحياتهم أو بسبب تشكك مشروع، عندما تتم بناء على طلب الوكيل العام لدى محكمة النقض، تظل مندرجة ضمن منطق استقلال القضاء، لأن هذا الأخير يمارس مسؤولياته في إطار السلطة القضائية نفسها، لا من خارجها.
وتذهب المحكمة أبعد من ذلك حين تصف الوكيل العام لدى محكمة النقض بأنه، إلى جانب صفته كرئيس للنيابة العامة، “ساهر على حسن سير الدعوى في مجال اختصاصها وعلى حماية النظام العام وصيانته”. هذا التوصيف، وإن جاء ضمن تعليل قانوني، يحمل بعدًا مؤسساتيًا وسياسيًا قويًا: فهو يضع النيابة العامة، في أعلى هرمها، في قلب معادلة حماية النظام العام القضائي والحقوقي، لا كخصم للأطراف، بل كضامن للتوازن بين سلطة القضاء وحقوق المتقاضين واستقرار المعاملات.
رابعًا: حدود سلطة الوكيل العام وضوابطها في ضوء القرار 255/25
مع أن القرار الدستوري وسّع من الاعتراف بمركز الوكيل العام وأدواره، فإنه في المقابل رسم حدودًا واضحة لا يمكن تجاوزها، سواء من طرف النيابة العامة أو المشرع نفسه.
أول هذه الحدود يتعلق بحجية الأحكام النهائية والأمن القضائي. فالمحكمة حينما أسقطت الفقرة الأولى من المادة 17، لم تنفِ عن النيابة العامة مسؤوليتها في حماية النظام العام، لكنها أكدت أن هذه الحماية لا يمكن أن تتم عبر فتح باب غير مضبوط لنقض الأحكام النهائية بدعوى مخالفة النظام العام، دون أن يحدد القانون حالات مضبوطة ومعايير دقيقة. وإلا تحولت سلطة النيابة العامة في هذا المجال إلى سلطة استثنائية واسعة تهدد استقرار المراكز القانونية
الحد الثاني يتصل بالإدارة القضائية ورقمنة المساطر. فالمواد 624 و628 من مشروع قانون المسطرة المدنية أسندت للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل تدبير النظام المعلوماتي القضائي ومسك قاعدة البيانات المتعلقة به، مع الإشارة إلى أن دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة هو مجرد “التنسيق”. المحكمة الدستورية رفضت هذا التصور، واعتبرت أن توزيع القضايا وتعيين القضاة عبر نظام معلوماتي، إذا كان مدبَّرًا من قبل وزارة العدل، يمس باستقلال السلطة القضائية، لأن هذه المهام ذات طبيعة قضائية صرفة، ويجب أن تظل بيد المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة داخل إطار السلطة القضائية لا خارجها.
في هذا الإطار، استحضرت المحكمة المادة 54 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، التي تنص على إحداث هيئة مشتركة بين المجلس والوزارة المكلفة بالعدل ورئاسة النيابة العامة للتنسيق في مجال الإدارة القضائية، وتعمل تحت إشراف كل من الرئيس المنتدب للمجلس والوزير المكلف بالعدل والوكيل العام، “بما لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية”. بهذا التعليل، ميزت المحكمة بين التنسيق المشروع في مجال الإدارة القضائية (الذي يشارك فيه الوكيل العام إلى جانب الوزير والرئيس المنتدب) وبين هيمنة تنفيذية على أدوات العمل القضائي (كالنظام المعلوماتي لتوزيع القضايا)، التي تعتبر غير مقبولة دستوريًا.
إذن، سلطة الوكيل العام لدى محكمة النقض ليست سلطة بلا قيود؛ فهي محكومة بحدود الأمن القضائي، وبالتوازن بين حماية النظام العام واحترام حقوق الدفاع، وبالإطار الدستوري لاستقلال القضاء عن السلطة التنفيذية، حتى وهو يمارس دوره كعضو في هيئة مشتركة للتنسيق الإداري.
خامسًا: رهانات القرار على مستقبل سلطة الوكيل العام والنيابة العامة
يُرتِّب القرار 255/25 آثارًا عملية تتجاوز مجرد مراقبة دستورية لنص قانوني، وتمتد إلى رسم معالم جديدة لدور الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئاسة النيابة العامة عامةً.
أول هذه الرهانات هو تكريس صورة الوكيل العام كضامن لـ“حسن سير الدعوى” لا بوصفه طرفًا يسعى فقط إلى الإدانة، بل كفاعل يسهر على احترام القانون، وتوازن مراكز الخصوم، وضمان احترام قواعد الاختصاص، وحياد القضاة، وصيانة النظام العام الإجرائي. صلاحية طلب الإحالة بسبب تجاوز القضاة لسلطاتهم أو التشكك المشروع لم تعد مجرد تقنية مسطرية، بل أضحت آلية دستورية تستند إلى استقلال القضاء، وتُمارس من داخل السلطة القضائية ذاتها.
ثانيًا، يعزّز القرار مكانة رئاسة النيابة العامة في النقاش العمومي والمؤسساتي حول إصلاح العدالة. فإذا كان نقل الإشراف على النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام قد شكّل محطة مفصلية في 2017، فإن قرار 2025 يأتي ليؤكد أن هذا الاختيار لم يكن مجرد خيار سياسي أو مؤسساتي، بل أصبح الآن محميًا بقراءة دستورية صارمة تمنع عودة أي شكل من أشكال الوصاية التنفيذية المقنَّعة على مجريات الدعوى القضائية.
ثالثًا، يضع القرار على عاتق الوكيل العام مسؤولية مضاعفة: فكلما توسعت سلطته في حماية النظام العام وحسن سير الدعوى، تضاعفت مسؤولية ترشيد استعمال هذه السلطة، بما يحقق التوازن بين حقوق الأفراد واستقرار القضاء من جهة، ومتطلبات حماية النظام العام والمصلحة العامة من جهة أخرى. هذا التوازن لن يتحقق فقط بالنصوص، بل أيضًا بثقافة قضائية جديدة داخل النيابة العامة، تقوم على الشفافية في التعليمات، واحترام الضمانات، والتواصل مع الرأي العام حول فلسفة القرار المتّخذ في القضايا الكبرى.
وأخيرًا، يدفع القرار إلى إعادة التفكير في حدود التداخل بين الشأن القضائي والشأن الإداري داخل المنظومة القضائية: فإذا كان الوكيل العام يشارك، بحكم النصوص، في الهيئة المشتركة لتدبير الإدارة القضائية، فإن القرار يذكّر بأن هذا الدور الإداري لا ينبغي أن يطغى على جوهر وظيفته القضائية، ولا أن يحوّله إلى شريك في إدارة “خارجية” للعدالة تُدار من منطق المرفق الإداري لا من منطق السلطة القضائية المستقلة.
خاتمة
يُظهر القرار الدستوري رقم 255/25 أن سلطة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض لم تعد مجرد مسألة تقنية تتعلق بتوزيع الاختصاصات بين الفاعلين، بل أصبحت جزءًا من “العقد الدستوري” الجديد الذي يحكم العدالة في المغرب. فمن خلال إسقاط اختصاصات استثنائية مُنحت لوزير العدل، والإبقاء على دور الوكيل العام رئيسًا للنيابة العامة في المساطر المرتبطة بحسن سير الدعوى، ومن خلال التأكيد على أن الإدارة القضائية لا يمكن أن تُدار خارج السلطة القضائية، رسمت المحكمة الدستورية حدودًا واضحة لاستقلال القضاء، وجعلت من الوكيل العام أحد أعمدته الأساسية، ضمن إطار من المسؤولية والرقابة والضوابط الدستورية.
بهذا المعنى، يمكن القول إن القرار 255/25 لم يُعدِّل فقط ملامح مشروع قانون المسطرة المدنية، بل أعاد أيضًا ترتيب المشهد القضائي حول فكرة محورية: لا حماية للنظام العام ولا لضمانات المتقاضين إلا بقضاء مستقل، ونيابة عامة يقودها الوكيل العام لدى محكمة النقض من داخل السلطة القضائية لا من خارجها.