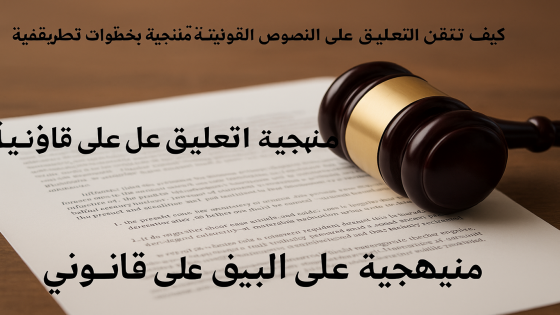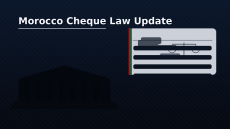يُعد التعليق على نص قانوني من أهم الدراسات التطبيقية في ميدان القانون، إذ يتطلب إتقان واستيعاب منهجية قانونية دقيقة. تقوم هذه المنهجية على مجموعة من الخطوات التي ينبغي اتباعها ضمن الخطة الكلاسيكية المعتمدة في كتابة البحوث القانونية، والتي تتضمن: مقدمة، موضوع، وخاتمة.
فما هي الخطوات المعتمدة في منهجية التعليق على نص قانوني؟
إن التعليق على نص قانوني هو محاولة لتفسيره وتوضيحه بأسلوب شخصي نسبي، من خلال تحليل مكوناته وعناصره، بهدف تقديم فكرة تركيبية شاملة عنه. ومن هذا المنطلق، نتناول أولًا المرحلة التحضيرية (المبحث الأول)، ثم المرحلة التحريرية للتعليق على نص قانوني (المبحث الثاني).
المبحث الأول: المرحلة التحضيرية للتعليق على نص قانوني
في هذه المرحلة، يُحلّل النص تحليلاً شكليًا وموضوعيًا.
المطلب الأول: الضوابط الشكلية للتعليق على نص قانوني
وتشمل التعليق على النص من الناحية الشكلية، من خلال المراحل التالية:
الفرع الأول: تحديد موقع النص وظروف صدوره
أولًا: تحديد موقع النص (المصدر الشكلي)
يتعلق الأمر بموقع النص ضمن المرجع المأخوذ منه، حيث يُذكر المصدر ورتبته ضمن سلم القواعد القانونية، كرقم المادة، الفصل، الباب، الكتاب، الجريدة الرسمية، ورقم العدد.
ثانيًا: تحديد تاريخ النص
يراعى تاريخ صدور النص، لما له من صلة بالظروف السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية الخاصة المحيطة به.
الفرع الثاني: التحليل الشكلي للنص
يتعلق الأمر بالشكل الخارجي أو الظاهري للنص:
1. البناء المطبعي (الطبوغرافي):
يوفر الشكل الخارجي للنص معلومات مهمة مثل طول أو قصر النص، عدد الفقرات، المصطلحات المستخدمة، ودلالاتها (كالتوكيد، الوجوب، الجواز، الإلزام، الأمر…).
2. البناء اللغوي والنحوي:
يتم شرح المصطلحات والكلمات المفتاحية لتفادي الخلط بين المفاهيم، مع تحديد أسلوب النص، والذي يكون غالبًا أسلوبًا خبريًا، ومدى بساطته أو تعقيده.
3. البناء المنطقي:
يعكس منطق النص من خلال الأسلوب المعتمد، سواء كان استنباطيًا، استقرائيًا، أو غير ذلك. بعض العبارات تساعد على تحديد هذا المنطق.
المطلب الثاني: التحليل الموضوعي للنص (الضوابط الموضوعية)
يرتكز على دراسة مضمون النص، أي القاعدة القانونية التي يتضمنها، ويتطلب ذلك قراءته عدة مرات وتحليل كل كلمة وفكرة.
الفرع الأول: استخراج الفكرة العامة للنص
وتتمثل في المعنى الإجمالي الذي يتضمنه النص، لتحديد موضوعه القانوني والهدف منه، حتى لا يخرج الباحث عن صلب الموضوع.
الفرع الثاني: استخراج الأفكار الأساسية
يُقسَّم النص إلى فقرات، مع تحديد بدايتها ونهايتها، واستخراج فكرة أساسية لكل فقرة.
الفرع الثالث: طرح الإشكالية
وهي السؤال القانوني الذي يطرحه النص. تُستخرج من المعنى العام، وتعبّر عن الفكرة التي يود النص توضيحها أو مناقشتها. يجب أن تكون الإشكالية واضحة، دقيقة، غير مركبة، وتُصاغ بصيغة استفهامية.
المبحث الثاني: المرحلة التحريرية للتعليق على نص قانوني
المطلب الأول: التصريح بالخطة
بعد طرح الإشكالية واستخراج الفكرة العامة والأفكار الأساسية، تُبنى خطة تمثل التصور العام للموضوع.
تُعد الخطة البناء الهيكلي للتعليق، ويجب أن تتسم بالتوازن، والربط المنطقي بين العناوين، وتجنب التكرار والتناقض، مع اعتماد مبدأ التقسيم الأحادي أو الثنائي.
يُستعان بالمراجع الفقهية والأحكام القضائية لتوفير المادة العلمية وتحليل النص.
المطلب الثاني: المناقشة
تشمل تحرير ما تضمنته الخطة، بدءًا بالمقدمة، مرورًا بصلب الموضوع، وانتهاءً بالخاتمة.
الفرع الأول: المقدمة
يتناول الباحث الفكرة الأساسية للنص، والعوامل التي أدت إلى صدوره، مع عرض موجز للمسألة القانونية موضوع الدراسة.
الفرع الثاني: دراسة صلب الموضوع
يتم تحليل النص وفقًا للخطة المعتمدة، دون إعادة صياغة النص نفسه، بل بشرح الأفكار، نقدها، وتقديم الرأي مدعومًا بالأسس القانونية المناسبة.
الفرع الثالث: الخاتمة
يُعرض فيها أهم النتائج المرتبطة بالإشكالية المطروحة، مع تقديم مقترحات لتعديل أو تحسين النص موضوع الدراسة، سواء من حيث الصياغة أو الأحكام، واقتراح بدائل تشريعية إن أمكن.
نموذج تطبيقي: التعليق على نص المادة 01 من القانون المدني الجزائري
نص المادة:
يسري القانون على جميع المسائل التي تتناولها نصوصه في لفظها أو في فحواها.
وإذا لم يوجد نص تشريعي، حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية،
فإذا لم يوجد، فبمقتضى العرف، فإذا لم يوجد، فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة.
مقدمة
طبيعة النص:
نص تشريعي مأخوذ من القانون المدني الجزائري.
مصدر النص:
المادة 01 من الباب الأول: آثار القوانين وتطبيقها، من الكتاب الأول: أحكام عامة، من الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975، المعدل والمتمم.
التحليل الشكلي
1. البناء المطبعي:
النص مكتوب بلغة واضحة وخالٍ من الأخطاء الطباعية، ويتكون من ثلاث فقرات قصيرة، مرتبطة بأدوات العطف (الواو، الفاء):
• الفقرة الأولى: “يسري القانون…” إلى “…فحواها.”
• الفقرة الثانية: “وإذا لم يوجد نص…” إلى “…العرف.”
• الفقرة الثالثة: “فإذا لم يوجد…” إلى “…العدالة.”
2. البناء اللغوي:
اللغة واضحة والمصطلحات دقيقة، من أبرزها:
• العرف: مجموعة من القواعد غير المكتوبة التي نشأت عن سلوك معتاد يلتزم به الناس ويعتقدون بإلزاميته.
• مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة: قواعد مستمدة من الفطرة الإنسانية والعدالة المجردة، تكتشف وتُطبَّق في غياب نصوص صريحة.
3. البناء المنطقي:
النص منطقي ومتسلسل، ويعتمد أسلوبًا خبريًا يُناسب الطابع القانوني.
التحليل الموضوعي
الفكرة العامة:
مصادر القانون المدني الجزائري تشمل: التشريع، الشريعة الإسلامية، العرف، ومبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة.
الأفكار الأساسية:
1. التشريع هو المصدر الرسمي الأول للقانون.
2. في حال غياب النص، يُلجأ إلى الشريعة الإسلامية والعرف.
3. تُستخدم مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة كمصدر احتياطي.
الإشكالية:
فيما تتمثل مصادر القانون وفقًا للقانون المدني الجزائري؟