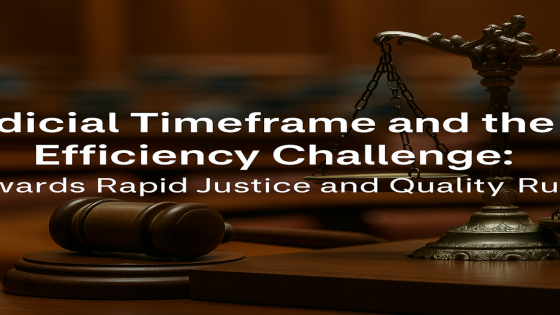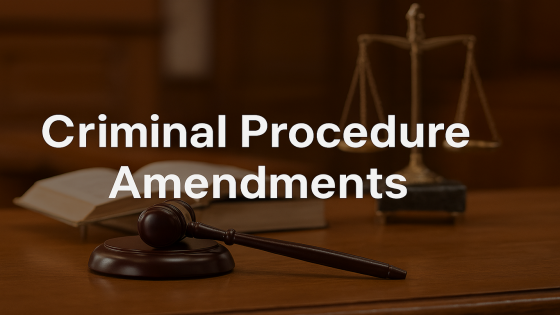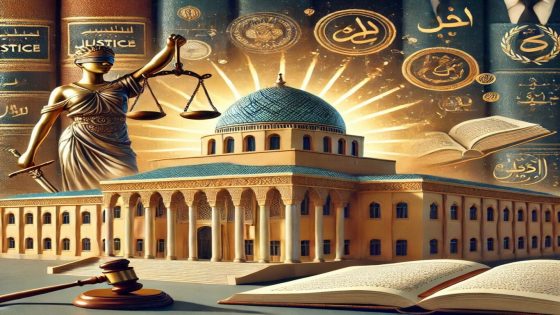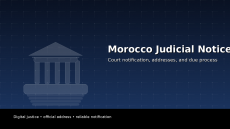تمهيــــــــــــــــــــــــــــــــد:
تُعد الحكامة القضائية من أقوى المفاهيم التي تضمنها دستور 2011، والتي ابتُغي من خلالها إحداث فارق إيجابي على مستوى عطاء المؤسسات القضائية، وولوجيتها، وجودة الخدمات التي تقدمها. ومن بين أهم المواضيع التي حظيت بالاهتمام تجسيدًا للحكامة الجيدة المبتغاة، تبرز ضرورة تدبير وعقلنة الزمن القضائي، بما يكفل تعزيز الثقة في مرفق العدالة.
ويُقصد بالزمن القضائي، في المفهوم الضيق، الأمد الذي تستغرقه الخصومة القضائية، والذي يمتد من تاريخ تقييدها في السجلات الرسمية للمحكمة إلى غاية استيفاء الحق المحكوم به عبر مسطرة التنفيذ. أما في مدلوله الواسع، فيشمل هذا المفهوم حتى الحقبة التحضيرية للخصومة، والتي تنطلق قبل تاريخ تسجيل الدعوى رسميًا عن طريق تدخل بعض الهيئات والأشخاص المكلفين بتقديم الخدمة القضائية، لمساعدة أطراف الخصومة في تأسيس الدعوى وصياغتها في قالب قانوني سليم.
وبما أنه يصعب ضبط هذه المرحلة الأخيرة افتراضيًا، بالرغم من أهميتها وتأثيرها المباشر على زمن الخصومة القضائية، بالنظر لكثرة المتدخلين فيها ولغياب تأطير معقلن وشامل لها سواء من الناحية الإجرائية أو اللوجيستيكية أو البشرية، فإن التعاطي مع موضوع الزمن القضائي يكون أكثر موضوعية إذا ما قصرنا البحث على المرحلة الظاهرة للخصومة القضائية، الممتدة من تاريخ دخولها رسميًا للمحكمة إلى حين انتهاء إجراءات التنفيذ المتعلقة بالحق المترتب عنها.
ويتميّز النظام القضائي المغربي، شأنه في ذلك شأن العديد من الأنظمة القضائية المماثلة، بتركيزه أوليًا على الشق الإجرائي للدعوى، والذي يقتضي اتباع سلسلة من المقتضيات المسطرية لتجهيز الدعاوى، بغية تمتيع المتقاضي بكامل حقه في التوصل، والحضور، وبناء الحجج. وبالنظر لما تتطلبه هذه الإجراءات من وقت ليس بالهين، فإنها قد تصبح سببًا مباشرًا في المس بضمانة دستورية كفلها للمواطن، وهي الحق في الحصول على عدالة سريعة وميسّرة.
فكيف يمكن التوفيق بين هذين المعطيين، أي الإبقاء على آلية الإجراء المسطري، لما في ذلك من ضمان لحق المتقاضي في إعداد أو رد الخصومة، وتسريع زمن البت في الملف تنفيذًا للمقتضى الدستوري المتعلق بالحصول على عدالة داخل أجل معقول؟ أو بصيغة أخرى: كيف يمكن التحكم في عمر الخصومة القضائية، بما لا يتنافى وتحقيق العدالة والحكامة القضائية؟
لتناول هذا الموضوع، ارتأينا بداية التطرق إلى مفهوم نجاعة الزمن القضائي كالتزام يقع على كل مكونات منظومة العدالة (محور أول)، ثم التعرض لمعيقات تحقيق النجاعة المبتغاة (محور ثاني)، ونُقدّم ثالثًا المقترحات الكفيلة بتخطي بعض هذه الصعوبات والرفع من منسوب الحكامة القضائية.
المحور الأول: عقلنة الزمن القضائي كالتزام يقع على مكونات منظومة العدالة
من جهة قضاة الحكم، فإن عقلنة زمن الخصومة تقتضي تمكين المتقاضي من حكم قابل للتنفيذ في أسرع الآجال، وتيسير تنفيذ هذا الحكم واقعًا وقانونًا.
أما قضاة النيابة العامة، فيتعين عليهم التدخل في الوقت المناسب بإجراءات حاسمة وحازمة لضبط مخالفي القانون وتقديمهم للعدالة، في احترام مطلق لضمانات المحاكمة العادلة، مع ترشيد الاعتقال، وتفعيل الإجراءات الاحترازية، وتقديم ملتمسات منسجمة مع الدور الأساسي والجوهري لهذا الجهاز القضائي، فضلًا عن الرفع من الفعالية عند تولي مهام تنفيذ الأحكام القضائية.
وبخصوص جهاز كتابة الضبط، فإن تدبير زمن الخصومة يقتضي السهر على تنفيذ الإجراءات القضائية في أقرب الآجال، تيسيرًا للحق في ولوج المواطن مرفق العدالة، وتزكية كذلك للثقة التي يفترض أن يوفرها هذا الجهاز، باعتباره أول متلقٍ للخصومة مبدئيًا.
أما الخبراء، فعليهم الامتثال للمهمة التي كُلّفوا بها داخل الآجال المحددة، والالتزام بمبادئ الشرف والموضوعية، إسهامًا منهم في تحسين جودة العدالة وتعزيز الثقة في أدائها.
وبالنسبة للمفوضين القضائيين، فهم الساهرون على إجراءات التبليغ والتنفيذ في عدد كبير من الملفات القضائية، ويتوجب عليهم إنجاز مهامهم في أقرب الآجال، بحرفية ومهنية عالية الجودة.
أما المحامون، فنجاعة زمن الخصومة تقتضي منهم التعاطي بإيجابية مع أطراف الدعوى، والمساهمة الفاعلة في تجهيز الملفات وتيسير مساطر التبليغ، من خلال تبنّي تقنيات حديثة تتماشى والتقدم الرقمي المشهود وطنياً.
ويُلاحظ أن القضاء المغربي، ووعيًا منه بثقل الالتزام الدستوري بعقلنة الزمن القضائي للخصومة، وبالرغم من إكراهات النص القانوني، عمل على مستوى أعلى مؤسسة قضائية، وهي محكمة النقض، على تبنّي مجموعة من المناهج، منها:
• اعتماد مخطط رقمنة المحكمة؛
• تقليص أمد البت في الملفات المعروضة؛
• إجازة تغيير المستشار المقرر إذا ظهر مانع قانوني أو موضوعي، من طرف الغرفة، دونما حاجة للرجوع إلى الرئيس الأول لمحكمة النقض؛
• مواجهة الطعون الكيدية تنفيذًا لمبدأ التقاضي بحسن نية؛
• تفعيل مبدأ العدالة الإجرائية من خلال تضييق مجال إيقاف البت في الدعوى المدنية، تطبيقًا للمادة 10 من قانون المسطرة الجنائية؛
• تفعيل دور النيابة العامة في ممارسة الرقابة الإيجابية لفائدة القانون، لتجاوز إمكانية إبطال الأحكام، وبالتالي التقليص من أمد الخصومة.
وهذا النهج هو كذلك ما اتبعته محاكم أول وثاني درجة، من خلال التقيد بالاجتهاد القضائي لمحكمة النقض، وتبنّي منطق المعالجة الفعالة للخصومة القضائية. كما أن وزارة العدل والحريات انخرطت هي الأخرى، كفاعل أساسي في منظومة العدالة، في إعداد برنامج متكامل بخصوص تدبير الزمن القضائي، واعتمدت في ذلك على مقاربة المعطيات الوطنية عبر ما تتوصل به من إحصائيات دورية من المحاكم، وتلك التي تتوصل بها من مؤسسة التفتيش القضائي.
المحور الثاني: معيقات تحقيق نجاعة الزمن القضائي
بالرغم من المجهودات التي أعطت إلى حد ما نتيجة إيجابية، فإن هناك مجموعة من العراقيل، منها ذاتية (أولًا)، وأخرى موضوعية (ثانيًا)، تُساهم في تمطيط أمد البت في الخصومة، وتُضعف بذلك مبدأ النجاعة القضائية.
أولًا: الأسباب الذاتية
يمكن تلخيص أهم هذه العراقيل في ما يلي:
• غياب التكوين في مجال تقدير المهل القضائية عند تولي تسيير الخصومة إجرائيًا، حيث يدبر كل قاضٍ تلك المهل بحسب قناعاته الذاتية، بعيدًا عن تدبير موضوعي وعقلاني. فقد نجد في بعض المحاكم خصومة معينة تدرج مرة أو مرتين في السنة لصعوبة التبليغ، في حين نجدها في محاكم أخرى تُدرج أكثر من ستين مرة في السنة لنفس السبب دون نتيجة تُذكر؛
• اتخاذ القاضي لمجموعة من إجراءات تحقيق الدعوى دون تبرير معقول؛
• تمديد النطق بالأحكام بشكل غير مبرر ومعقلن؛
• الإخراج من المداولة أو التأمل لأسباب إجرائية كان من الممكن تلافيها بواسطة الدراسة القبلية للملفات؛
• الاكتفاء بالتطبيق الحرفي للنص القانوني دون التعمق في روح النص التشريعي والبحث عن الغاية المثلى منه؛
• تسريع البت في الملفات للحصول على تقييم مميز للمحكمة، على حساب جودة الأحكام، التي تُحدد مقاييسها في مقرر اللجنة الأوروبية حول النجاعة القضائية؛
• إصدار أحكام بعدم الاختصاص النوعي أو بعدم القبول، بعد أن يكون الملف قد قضى أشواطًا طويلة أمام المحكمة.
ثانيًا: الأسباب الموضوعية
وتتجلى في:
• تعثر وتأخر التشريع عن مواكبة التطور والسرعة التي يقتضيها البت الناجع في القضايا.
• على سبيل المثال، الدفع بعدم الاختصاص المكاني لا يستلزم البت فيه أجلًا معينًا أو ردًا أوليًا، مما يؤدي إلى قضايا ممدّدة زمنيًا، إذ تُحال القضية على المحكمة المختصة مكانيًا بعد مدة من تسجيلها بالمحكمة المُحيلة، لتنطلق مرحلة جديدة لتجهيز الملف، تتطلب إجراءات جديدة تمتد بحكم النص القانوني.
• عدم اعتماد النصوص القانونية المنظمة لإجراءات التبليغ على آلية التبليغ الإلكتروني، بما يتناسب مع معطى المحكمة الرقمية.
• غياب تأطير علمي وموضوعي للقاضي، سواء خلال مرحلة التكوين الأساسي بالمعهد العالي للقضاء أو في التكوين المستمر، يؤهله لتحقيق التوازن بين تدبير الزمن وجودة الأحكام.
المحور الثالث: الحلول المقترحة لتفعيل النجاعة القضائية عبر آلية التدبير السليم للزمن القضائي
من أبرز الحلول المقترحة:
• عقلنة الخريطة القضائية بما يتناسب مع معطى المحكمة الرقمية، وذلك بتحرير الخصومة من آليات التبليغ التقليدية، والاعتماد على مبدأ التقاضي عن بعد، لما يوفره من مقومات جودة الأداء القضائي؛
• انخراط الجمعيات المهنية القضائية في ورش النجاعة القضائية، من خلال الإسهام في إعداد ندوات، وورشات، ودورات تكوينية لفائدة القضاة وكل مكونات منظومة العدالة، تُرفع فيها التوصيات للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
• تفعيل دور الجمعية العامة للمحاكم من خلال تدارس المعدل الزمني الذي تقضيه الخصومة، واقتراح الحلول المناسبة لتجاوز التأخير؛
• الاعتماد على آلية التبليغ الإلكتروني كأساس في المساطر القضائية، مع الاحتفاظ بالتبليغ العادي كحل بديل في حالات خاصة ومحدودة؛
• ربط مكاتب المفوضين القضائيين بخط اتصال إلكتروني مباشر بالمحاكم التي يعملون في دائرة نفوذها، لتسهيل تداول الإجراءات، خاصة وأنها ترتبط مباشرة بمسطرتي التبليغ والتنفيذ، اللتين تُشكلان أهم بنية إجرائية تتحكم في زمن الخصومة.
خاتمـــــــــة:
إن كل ما أثير بشأن هذا الموضوع يُفضي إلى خلاصة مفادها أن رهان النجاعة القضائية يقتضي التعاطي بحكمة وموضوعية مع كافة المعطيات والعوامل المحيطة بالخصومة القضائية، والإسهام في الرفع من منسوب العدالة والأمن القضائي، بما يكفل رقي المجتمع والوطن.