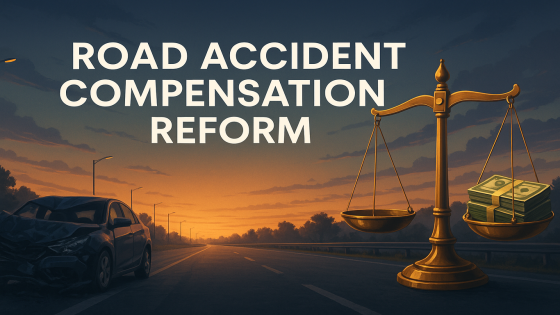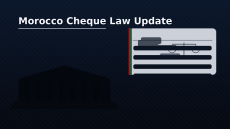مقدمــــــــــــــة
قلّما يمرّ أسبوع في المغرب دون أن نسمع عن حادثة سير مميتة أو إصابة خطيرة تُغيِّر حياة أسرة بأكملها. وراء كل رقم في نشرات الأخبار وجهٌ حقيقي، وعائلة تحاول التكيّف مع فقدان مُعيل أو عجز دائم، وفي المقابل منظومة تعويضٍ وُضعت في ثمانينيات القرن الماضي وظلّت، لأكثر من أربعين سنة، عاجزة عن مواكبة التحوّلات الاجتماعية والاقتصادية التي عرفها البلد.
في هذا السياق جاء مشروع القانون رقم 70.24 المتعلق بتعديل وتتميم الظهير الشريف رقم 1.84.177 الصادر في 2 أكتوبر 1984 بشأن تعويض ضحايا حوادث السير الناتجة عن عربات برية ذات محرك. المشروع لا يكتفي بتحيين الأرقام، بل يعيد النظر في تعريف “الأجر”، وفي آجال التقادم، وفي لائحة المستفيدين، وفي فلسفة التعويض نفسها، في محاولة لإعادة التوازن بين حقوق الضحايا من جهة، واستقرار قطاع التأمين من جهة أخرى.
أولاً: الخلفية التشريعية والغاية من الإصلاح
الإطار الحالي للتعويض عن حوادث السير يستند إلى ظهير 2 أكتوبر 1984، الذي وُضع في سياق اقتصادي واجتماعي مختلف تماماً عن واقع اليوم. خلال أربعة عقود، ارتفعت كلفة المعيشة بشكل كبير، وتطوّر مفهوم المسؤولية المدنية والتعويض عن الضرر في الاجتهاد القضائي والفقه، لكن جداول التعويضات وبنية النص الأصلي ظلت تقريباً على حالها.
الحكومة صادقت، في اجتماعها بتاريخ 4 شتنبر 2025، على مشروع القانون رقم 70.24، قبل إحالته إلى البرلمان، حيث قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب يوم 21 أكتوبر 2025.
حسب الشروحات الرسمية والتقارير الصحفية، يهدف المشروع إلى:
• تحديث نظام التعويض بما يساير التطور الدستوري الذي كرّس كرامة الإنسان والعدالة الاجتماعية.
• رفع مستوى الحماية الممنوحة للضحايا وأسرهم، من خلال مراجعة أسس احتساب التعويض.
• تحقيق توازن دقيق بين تعويض عادل وكريم من جهة، وعدم الإضرار بالتوازنات المالية لقطاع التأمين من جهة أخرى.
بمعنى آخر، نحن أمام ورش إصلاحي يروم الانتقال من منطق “الحد الأدنى للبقاء” إلى منطق “التعويض المنصف” الذي يعترف بحجم الضرر الجسدي والمعنوي والاجتماعي.
ثانياً: رفع التعويضات… عندما تتكلم الأرقام
العنصر الأكثر تداولاً إعلامياً في مشروع القانون 70.24 هو رفع الحد الأدنى للأجر المعتمد في جداول التعويض بنسبة كبيرة. فالمنظومة الحالية تعتمد “مبلغاً مرجعياً” (montant plancher) يناهز 9.270 درهماً، وهو رقم لم يعد يعكس واقع الأجور ولا كلفة العيش في المغرب.
المشروع ينصّ على:
• زيادة هذا المبلغ المرجعي بنسبة 54٪ تدريجياً وعلى خمس مراحل، ليصل في المرحلة النهائية إلى 14.270 درهماً.
• اعتماد آلية مرنة لتحيين الحدود الدنيا والقصوى للتعويض كل خمس سنوات، بدل ربطها بأنظمة وظيفية قديمة.
هذا الرفع لا يعني منح مبلغ قار بنفس القيمة لكل الضحايا، لأن التعويض يظل خاضعاً لمعايير متعدّدة (سنّ الضحية، نسبة العجز، طبيعة الضرر، الدخل…) لكنّه يرفع “القاع” الذي تُحتسب انطلاقاً منه التعويضات، وبالتالي تعويضات أعلى في أغلب الحالات، خاصة في حالات العجز الدائم والوفاة.
إلى جانب ذلك، يضيف المشروع مصاريف جديدة قابلة للاسترجاع، من قبيل:
• كلفة إصلاح أو استبدال الأجهزة الطبية (مثلاً كرسي متحرك، أطراف اصطناعية…).
• تكاليف التحاليل الطبية المرتبطة بالإصابة.
كما ينص على استثناء بعض المصاريف من قاعدة المسؤولية المشتركة (مثل مصاريف الدفن ونقل الجثمان والتعويض المعنوي عن الوفاة) حتى لا تُحمَّل الأسرة جزءاً من هذه الأعباء بسبب مساهمة الضحية – مثلاً – في وقوع الحادث.
من يستفيد هنا؟
• كل ضحية إصابتها أدت إلى عجز جزئي أو كلي ستستفيد من تعويض مالي أعلى.
• أسر الضحايا المتوفين ستستفيد من تغطية أفضل لمصاريف الجنازة ونقل الجثمان، وتعويض معنوي يُحتسب على قاعدة أعلى.
• الأشخاص الذين يحتاجون لأجهزة طبية دائمة، سيجدون أنفسهم لأول مرة أمام نص يأخذ هذه الكلفة بجدية.
ثالثاً: توسيع دائرة المستفيدين… الاعتراف بالروابط الأسرية والاجتماعية الجديدة
إحدى أهم نقاط قوة المشروع، والتي تُجيب مباشرة عن سؤال “من يستفيد؟”، هي توسيع لائحة المستفيدين من التعويض. فالظهير القديم كان يركّز أساساً على الزوجة والأبناء والوالدين، بشكل كلاسيكي لا يراعي تطوّر أنماط الأسرة والعلاقات الاجتماعية.
مشروع القانون 70.24 يقترح أن تشمل دائرة المستفيدين:
• الأبناء المكفولين (في إطار نظام الكفالة)، أي الطفل الذي يعيش في كنف أسرة حاضنة دون أن يكون ابناً بيولوجياً لها، انسجاماً مع مدونة الأسرة.
• الآباء الكافلون في حالة وفاة الطفل المكفول، اعترافاً بالروابط العائلية والالتزامات التي تنشأ عن الكفالة.
• الزوج أو الزوجة العاجز(ة) عن الإنفاق على نفسه، أي الذي يُثبت أن الضحية كانت تُنفق عليه فعلاً.
• الطلبة والمتدربون في التكوين المهني أو التعليم العالي، ممن لا يتوفرون على دخل قار ولكنهم في بداية مسارهم المهني.
• البنات يُعفيهن المشروع من ضرورة تقديم دليل على “الاعتماد المالي” على الهالك، انسجاماً مع مقتضيات مدونة الأسرة التي تستحضر وضعية البنات داخل الأسرة.
في الواقع، هذه المقتضيات تنصف فئاتٍ كانت في الهامش، مثل:
• طفل مكفول يفقد “أباه الحاضن” في حادثة سير، فيجد نفسه قانونياً دون حماية تعويضية، رغم أنه فقد المعيل الفعلي.
• زوجة مريضة أو معطلة كانت تعيش كلياً على نفقة زوجها المتوفى، لكنها لا تستطيع إثبات “الاعتماد المالي” بسهولة.
• طالب جامعي أو متدرب في معهد مهني، لا يتقاضى أجراً، لكن وفاته أو عجزه يخلّف أثراً مالياً ومعنوياً كبيراً على أسرته.
المشروع يحاول أن يُقرّ أن الخسارة الإنسانية لا تقتصر على من يوقّع عقد العمل، بل تمتد لكل من كان يعتمد فعلياً على الضحية في حياته اليومية.
رابعاً: حماية العاملين في القطاع غير المهيكل وحرية إثبات الدخل
إشكال آخر ظلّ يطارد ضحايا حوادث السير، هو صعوبة إثبات الدخل الحقيقي في حالات العمل غير المهيكل أو العمل الحر. في التطبيق، كثيراً ما كانت شركات التأمين تتشبّث بالأجر المصرّح به أو بالحد الأدنى للأجر، حتى لو كان الضحية يحقّق دخلاً أعلى بكثير من نشاط تجاري أو مهني غير موثق.
مشروع القانون 70.24 يكرّس، لأول مرة بشكل واضح، مبدأ حرية الإثبات في تحديد الدخل، ولا سيما لفائدة:
• العاملين في القطاع غير المهيكل (باعة متجولون، حرفيون، سائقي سيارات الأجرة غير المهيكلين…)
• أصحاب المهن الحرة غير المنظمة بشكل كامل.
• الأشخاص الذين اشتغلوا أقل من سنة قبل الحادث، أو حصلوا على زيادة في الأجر خلال الأشهر الاثني عشر السابقة.
النص يسمح بالاستناد إلى كل وسيلة مشروعة لإثبات الدخل (شهود، تحويلات بنكية، فواتير، عقود عرفية…)، مع التنصيص على أن الأجر الذي يُعتدّ به هو الأجر الصافي بعد خصم الضرائب عند احتساب التعويض.
بهذا التوجه، يستفيد:
• سائق سيارة أجرة يشتغل بعقد عرفي ويُصرَّح له بدخل أقل من الواقع، فيمكنه أن يثبت دخله الحقيقي.
• حرفي أو مقاول ذاتي يعتمد على فواتير أو تحويلات إلكترونية لإثبات متوسط دخله الشهري.
• عامل موسمي اشتغل لمدة أقل من سنة، أو حصل على زيادة أخيرة في أجره، فلا يُظلَم باعتماد أجر ضعيف أو قديم.
هذه النقلة تُقرب النظام المغربي من منطق “التعويض عن الضرر الفعلي” بدل التعويض وفق أرقام نظرية بعيدة عن الواقع.
خامساً: تبسيط المساطر، تشجيع الصلح، وملاءمة آجال التقادم
لا يكفي أن تكون مبالغ التعويض مرتفعة على الورق، إذا كانت المساطر طويلة ومعقّدة تجعل الوصول إلى هذه التعويضات معاناة إضافية للضحية. لهذا أدخل مشروع القانون 70.24 مجموعة من المقتضيات المسطرية المهمة.
1. آجال التقادم
المشروع يوحّد آجال التقادم المتعلقة بطلبات الصلح ومراجعة التعويض في حالة تفاقم الضرر، ويجعلها خمس سنوات، بدل آجال أقصر في النص الحالي (سنتان في بعض الحالات).
كما ينظم بشكل أدق حالات وقف وانقطاع التقادم، حتى لا تضيع حقوق المتضررين بسبب عراقيل مسطرية أو تأخّر الخبرة الطبية.
من يستفيد؟
• الضحايا الذين لا تظهر كل آثار إصابتهم إلا بعد مدة (مثلاً مضاعفات عصبية أو نفسية)، فيمنحهم النص مزيداً من الوقت لمراجعة التعويض.
• أسر الضحايا التي قد تحتاج وقتاً لتجميع الوثائق والتفاوض مع شركة التأمين.
2. تشجيع التسوية الودية (الصلح)
المشروع يجعل من الصلح طريقاً أساسياً للحصول على التعويض، مع:
• الإبقاء على إجبارية الصلح، ولكن مع تبسيط مسطرته واختصار الآجال.
• اعتماد نموذج موحد للشهادة الطبية، يحدّد بدقة نوع الإصابة وسُلم العجز، لتقليص النزاعات التقنية.
• تعزيز التعاون بين الطبيب المعالج وطبيب شركة التأمين، وإقرار نوع من الخبرة الطبية المشتركة.
• تقليص آجال معالجة ملفات التعويض، بحيث يحصل الضحية على جوابه في زمن معقول.
الرهان هنا هو أن يستفيد الضحية من تعويض أسرع وأقل كلفة، بدل الدخول في نزاعات قضائية لسنوات. لكن في المقابل، يطرح هذا التوجه تحدّياً عملياً:
• هل يتوفّر الضحايا على المعلومة الكافية للتفاوض بندية مع شركات التأمين؟
• هل سيواكب المحامون هذا المسار دون أن يتحوّل الصلح إلى أداة لفرض مبالغ أقل مما يستحقه الضحايا؟
مع ذلك، يظل تبسيط الصلح وتسريع المساطر مكسباً حقيقياً، خصوصاً للفئات الهشة التي لا تتحمّل تكاليف التقاضي الطويل.
سادساً: التوازن مع قطاع التأمين… بين خطاب الطمأنة وحدود الإصلاح
منذ الإعلان عن مشروع القانون 70.24، برز سؤال مركزي في الإعلام والوسط المهني: هل سيؤدي رفع التعويضات إلى ارتفاع أقساط التأمين التي يدفعها المواطنون؟
وزير العدل حاول طمأنة الرأي العام، مؤكداً أن الرفع من التعويضات لن ينعكس على أقساط التأمين التي يؤديها المؤمنون، وأن الإصلاح يستهدف بالأساس إعادة توزيع أفضل للموارد داخل المنظومة التأمينية نفسها.
في المقابل، عبّرت بعض المقالات التحليلية عن تخوّف من أن يتحوّل المشروع إلى نصّ يميل كثيراً إلى منطق عقود التأمين، أي إلى قراءة تقنية قد تُضعِف الحضور الإنساني والقضائي في تقدير الضرر، معتبرة أن النص الجديد “يشبه عقد تأمين أكثر مما يشبه قانوناً لحماية الضحايا”.
إلى جانب ذلك، يطرح الإصلاح أسئلة أخرى:
• هل سيتم تحيين جداول التعويض في آجال معقولة وبمشاركة كافية للخبراء والقضاة والمهنيين؟
• هل تتوفر المحاكم على تكوين متخصص في قراءة وتطبيق هذه الجداول الجديدة، خاصة في ما يتعلق بتقدير الضرر المعنوي والنفسي؟
• هل سيتم تنظيم حملات تواصلية كافية لشرح حقوق الضحايا وأسرهم، حتى لا يبقوا رهائن لتفسيرات شركات التأمين؟
مع ذلك، يتفق العديد من المتتبعين على أن المشروع، رغم ما قد يُسجَّل عليه من ملاحظات، يمثّل قفزة نوعية مقارنة بالنظام الحالي، لأنه يرفع التعويضات، ويوسّع المستفيدين، ويُدخل منطق الكرامة والعدالة في صلب فلسفة التعويض.
خاتمة: من يستفيد فعلاً من رفع التعويضات في مشروع القانون 70.24؟
بالعودة إلى السؤال الذي انطلقنا منه – “من يستفيد من مشروع القانون 70.24؟” – يمكن تلخيص الجواب في المستويات التالية:
1. الضحية المباشرة للحادث
تستفيد من تعويض مالي أعلى بفضل رفع المبلغ المرجعي بنسبة 54٪، وإدخال مصاريف جديدة قابلة للاسترجاع، واعتراف أفضل بالأضرار الجسدية والمعنوية.
2. أسرة الضحية
تستفيد من توسيع لائحة المستفيدين لتشمل الأبناء المكفولين، والآباء الكافلين، والزوج العاجز، والبنات دون اشتراط إثبات الاعتماد المالي، مع حماية أفضل في حالة الوفاة (مصروف الدفن ونقل الجثمان والتعويض المعنوي)
3. العاملون في القطاع غير المهيكل وأصحاب المداخيل غير القارة
يستفيدون من مبدأ حرية الإثبات في تحديد الدخل، بما يسمح بتعويض أقرب إلى الدخل الحقيقي، لا إلى أرقام نظرية أو مصرح بها شكلياً فقط.
4. الطلبة والمتدربون والشباب في بداية المسار المهني
يُعترف لأول مرة بحقهم في تعويض يأخذ بعين الاعتبار مستقبلهم المهني المحتمل، لا مجرد وضعهم الحالي بدون أجر.
5. المنظومة القضائية ككل
تستفيد من نص أكثر وضوحاً في التعاريف والآجال، ومن آليات للتسوية الودية والخبرة الطبية المشتركة، ما قد يُخفّف العبء عن المحاكم ويُسرّع وتيرة البت في الملفات.
في النهاية، مشروع القانون 70.24 ليس مجرّد عملية تقنية لرفع تعويضات ضحايا حوادث السير، بل هو اختبار حقيقي لقدرة الدولة على ترجمة شعارات العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية إلى أرقام ومعايير ومساطر ملموسة.