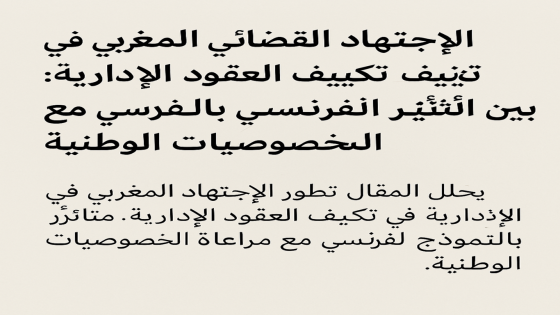تستمد معظم قواعد الصفقات العامة والعقود الإدارية بالمغرب أساسها من الأنظمة الفرنسية التي تم تنقيلها، أن ذلك التنقيل لم يمنع من بناء وتكوين أنظمة قانونية مستقلة. كما أن التشابه بينها لا يسحب من المنازعات التعاقدية تميزها واستقلاليتها وخصوصيتها، التي تستمدها من طبيعة المجتمع التي تنشأ فيه. إلا أن المقاربة المعيارية للعقود الإدارية كانت ولازالت تحمل بصمات الاجتهاد القضائي الفرنسي لأسباب تعود الى الروابط التاريخية التي شكلت السبب في تغيير التاريخ السياسي والإداري والقضائي والقانوني لبلد المغرب. وكان ذلك التغيير وراء إشعاع النظريات والرؤى الفرنسية، وتأثيرها المباشر وغير المباشر في مقاربة العقد الإدارية.
ويؤكد قولنا ما تشمله أحكام القاضي الإداري المغربي من صيغ وبنى فكرية وإحالات على المرجعية الفرنسية، عند تعليل الفصل في المنازعة التعاقدية أو تبرير المعيار المميز للعقود الإدارية ذات الطابع غير المألوف القابلة للانطباق عليها، بل إن الأسس القانونية لتمييز ومقاربة العقد الإداري تعود الى مرحلة الاستعمار أو الحماية، قبل أن تشملها التحولات والإصلاحات التي شهدها النظام القضائي تدريجيا. وإذا كانت معايير العقد الإداري تطرح بشكل متفاوت في هذه الإصلاحات، فإن حدتها ارتبطت في معظم الأحوال بمنازعات الإلغاء، وازدادت مع إحداث المحاكم الإدارية المغربية، وتفعيل رقابتها وهي مرشحة لاحتلال مكان الصدارة والأولوية في ظل تفعيل رقابة المحاكم الإدارية ونظام مجلس الدولة في الآفاق المستقبلية.
وإذا كانت منازعات العقود الإدارية قد تبلورت في صلة وثيقة بالاجتهاد القضائي المقارب للطبيعة الإدارية للعقد، فإن معيار تمييز هذا الأخير قد مر حتما بمرحلة توظيف المعيار العضوي الذي ينظر الى طبيعة الشخص العمومي الذي يكون طرفا فيها، ثم بمرحلة المزاوجة بين المعيارين العضوي والمادي التي نالت تقريبا إجماع الفقه والقضاء الإداري.
والاتجاه الغالب في القضاء المغربي، يعطي الأولوية للمعيار العضوي باعتباره شرطا أساسيا يقترب من أن يكون مسلمة لا محيد عنها لطبع العقد بالطابع الإداري. غير أن اعتبار الشخص العام طرفا فيه ليس شرطا كافيا لاعتباره عقدا إداريا باستمرار وفي كل الحالات. وعندما يتحقق القضاء من توفر هذا الشرط الأدنى، يبحث في الشروط الموضوعية الأخرى. وقد اشترط أحيانا توفر معايير ثلاثة، انطلاقا من مقاربته الشمولية، في حين اكتفى في بعض الحالات بمقاربة معيارية جزئية تجمع بين المعيار العضوي وأحد الشروط الموضوعية، وتعامل مع هذه الأخيرة بطريقة بديلة تسمح لا لأحد الشرطين بأن يعوض وينوب عن غياب الآخر. أما أحيانا أخرى، فقد اكتفى بالبحث عن وجود أو توفر شرط أو معيار واحد. غير أنه ينبغي التمييز داخل الاجتهاد القضائي بين الأحكام التي تعلن عن المبادئ وتصوغ النظريات، فهذه الأحكام تبنت مقاربة شمولية ووظفت الفقه كمرجعية، وبين الأحكام التي تعلن مبادئ لصيقة بالحالة المعروضة، فهي غالبا ما تترك المرجعية النظرية خفية ومضمرة. ولاحظنا أحيانا أن القاضي يكتفي بتأكيد وإعادة إنتاج المعيار التشريعي أو ما هو متداول في الفقه النظري من تعاريف أحيانا أخرى. وبحث توجهات القاضي المغربي في مجال مقاربته الميعارية للعقد الإداري تقتضي التمييز بين موقف المجلس الأعلى وموقف المحاكم الإدارية.
المبحث الأول:مقاربة المجلس الأعلى للعقد الإداري
اقترنت انطلاقة المجلس الأعلى بالتحولات التي طرأت على الاجتهاد القضائي الفرنسي المتعلق بمقاربة العقد الإداري، حيث كانت قد صدرت عنه مجموعة من الأحكام وكذا عن محكمة التنازع تؤرخ لتلك التحولات، حيث تحولت عن المقاربة الشمولية المطلقة الى المقاربة الموضوعية مع الإقرار بالوظيفة البديلة التعويضية لشروطها أو التسليم بإمكانية المزاوجة بينهما بما يلائم ظروف كل قضية. وقد أعاد الاجتهاد الفرنسي الاعتبار لمعيار المشاركة في المرفق العام تارة، ولشرط وجود بنود غير مألوفة في القانون الخاص تارة أخرى، وقرر أحيانا عدم كفاية أحدهما دون توفر الشرط الآخر.
وقد حاول الفقه الفرنسي تأصيل ذلك الاجتهاد، فتميزت محاولاته ومجهوداته الفكرية بالتضخيم والإفراط والنفخ في قيمة إحدى الشروط على حساب غيرها.
ومن الطبيعي أن يكون للاجتهاد الفرنسي تأثيره على المجلس الأعلى، الذي عمد في مقاربته للعقد الإداري الى توظيف المعايير المذكورة مجتمعة أحيانا أو استعمال عناصر المعيار الموضوعي بطريقة بديلة تعاقبية (4)، أحيانا أخرى، أخذا بعين الاعتبار البيئة العامة للعقد وما يحيط بها من ملابسات وسالكا في بحثه أسلوب البساطة والسهولة في الاستدلال وتقديم الحجة (5). غير أن هناك بعض التفاوت يسجل في اجتهاد المجلس الأعلى، فخلال قرن باشر مقاربته المعيارية بأسلوب خفي مستتر، باحثا عن شروط العقد دون الإشارة الى مرجعيتها الفقهية أو القضائية، غير أنه عندما تحول الى محكمة استثماف إدارية شدد على الخلفية النظرية والمرجعية القضائية للعقد الإداري في الوقت الذي باشر البحث في مدى كفاية الشروط المتوفرة في العقد أو عدم كفايتها بمناسبة المنازعة المعروضة عليه.
الفقرة الأولى : النظام المرجعي لمقاربة وتكييف العقد الإداري
إن النظام المرجعي الذي تنسب إليه مزايا بناء وتشييد نظرية العقود الإدارية، يفتقر في الواقع إلى ذلك التماسك والاستقرار النظري. فقد أدت تعقيدات الواقع الى لزوم إدخال تحويرات على النظرية، وبررت وجود استثناءات على القواعد المبدئية مقابلة لها على مستوى الممارسة والنهج القضائي.
هذا، وينبغي الإشارة الى أن الفقه والقضاء في فرنسا، قد استقر في النصف الأول من القرن العشرين، على أن المعيار المميز للعقود الإدارية عن العقود المدنية يكتمل باجتماع ثلاثة شروط ينبغي أن تتوافر مجتمعة في العقد لكي يعتبر من العقود الإدارية، أما إذا تخلفت كلها أو بعضها فإن العقد يكون مبدئيا. فينبغي طبقا لذلك التصور السائد، أن يكون طرفي العقد شخصا من أشخاص القانون العام ، وأن يتصل بتسيير مرفق عام ، وأن تسلك الإدارة بشأنه قواعد القانون العام على أن يتضمن بنودا غير مألوفة في عقود القانون الخاص.
وهذا التصور الذي ربط تعريف العقد الإداري باكتمال الشروط والمعايير الثلاثة التي درجت مؤلفات القانون والقضاء الإداري على شرحها وتحليلها لتركيب وبناء نظرية العقد الإداري كانت تجد سندها في عدة أحكام صدرت عن مجلس الدولة ومحكمة التنازع في فرنسا (10). كما وجد في الاجتهاد القضائي المصري، ما يقابلها ويؤكدها ويقر بلزوم اجتماع المعايير المشار إليها مرة واحدة في العقد ليعتبر من العقود الإدارية التي تختص المحاكم الإدارية بالنظر فيها.
غير أن حكمين مبدئيين صدرا عن مجلس الدولة الفرنسي في قضية الزوجين برتان بتاريخ 20 أبريل (12) 1956، وفي قضية شركة النقل كوندوران إخوان بتاريخ 11 ماي 1956 (13) قضيا بالعدول عن المبدأ السابق القاضي بضرورة اجتماع الشروط الثلاثة في العقد ليعتبر إداريا، واكتفيا باجتماع شرطين فقط، كمعيار لوصف العقد بأنه إداري.
وطبقا لهذا التصور الجديد، يكون وجود أحد الأشخاص العامة طرفا في العقد شرطا لازما على الدوام، على أن يدعم بوجود أحد الشرطين الآخرين، على اعتبار أن كل واحد منهما، يمكن أن يعوض الآخر أو ينوب عنه، ويكتفي بأحدهما الى جانب الشرط الأساسي في تكييف العقد على أنه من طبيعة إدارية.
وقد ثبتت محكمة التنازع الفرنسية ذلك التوجه القضائي الجديد لمجلس الدولة ابتداء من سنة 1958، وقررت أن العقد يعتبر إداريا ولو لم يتضمن شروطا استثنائية، وإذا شارك المتعاقد مباشرة في القيام بمهمة المرفق العام ذاتها، وأن العقد الذي يكون موضوعه تنفيذ المرفق العام ذاته يعتبر عقدا إداريا.
وقد تبين من التوجه القضائي الجديد أن علاقة العقد بالمرفق العام قد أعيد لها الاعتبار، طالما أن العقد حسب هذا الاجتهاد يعتبر بطبيعته عقدا إداريا ولو لم يتضمن بنودا غير مألوفة. كما اعتبر اتصال العقد بالمرفق العام معيارا رئيسيا، وهو ما أدى ببعض الفقه (16) الى تسجيل تلك الحقيقة والقول بأن معيار البنود غير المألوفة، ولو لم يهجر من طرف القضاء، إلا أنه أصبح يرتب في الدرجة الثانية ويلعب دورا ثانويا، بالمقارنة مع الأهمية والاعتبار الذي أحاط به القضاء والفقه معيار اتصال العقد بالمرفق العام.
وقد كان لهذا التصور الجديد تأثيره على القضاء المصري، الذي عمد الى تنقيله، وصياغة أحكامه على هداه، بشكل لا يترك مجالا للشك، بل إن الأحكام المصرية أوضح وأدق من غيرها (18) في إبراز علاقة العقد بالمرفق العام. غير أن هذا الشرط لا يكون كافيا دائما، لذلك لابد من الأخذ بالمعيار الموضوعي المزدوج الذي يقرن الطبيعة الإدارية للعقد بعلاقته بالمرفق وبوجود بنود غير مألوفة فيه، ذلك لأن المرفق العام لا يكون دائما على درجة كافية من الوضوح خصوصا مع التطور الذي عرفته المرافق العامة، والتحولات التي طرأت عليها من حيث نظامها القانوني، كما أن الإدارة القائمة على تلك المرافق لا تتصرف دائما طبقا لقواعد القانون العام وامتيازاته وعليه فإن وجود الشروط أو البنود الاستثنائية غير المألوفة في العقد يفرض نفسه كشرط لازم لتمييز العقد في بعض الحالات. فما هي الممارسة القضائية المغربية، وما هي الاختيارات المعيارية لقضائها في تكييف ووصف العقود الإدارية، وما هي نتائجها على تكييف المنازعة التعاقدية في كليتها وعلى الاختصاص القضائي ؟ وما هي السياسة القضائية المتبعة في توظيف المعايير والمؤشرات المميزة للعقد الإداري ؟
وينبغي دراسة الموضوع مع مراعاة خصوصية دعوة الإلغاء ودعوى التعويض وباعتيار السياقات التاريخية لتطور بنيات التنظيم القضائي.
الفقرة الثانية : مرحلة ما قبل إحداث المحاكم الإدارية
مارس المجلس الأعلى تكييفه للعقد عبر الاستدلال العملي على توفر شروطه، لاعتمادها حجة في القضية المعروضة عليه دون أن يجهد نفسه لإحاطتها بالمرجعية النظرية أو الإشارة الى أصولها الفقهية والقضائية، وتجنب التأكيد عليها وإبرازها وجعلها قضية مهيمنة على المنازعة أو تحظى بالأولوية فيها، وكأن مشكلة المعيار تحتل مرتبة ثانوية في تكييف العقد الإداري، غير أن طريقته في الاستدلال تؤكد تشبعه بمبادئ وثقافة العقد الإداري ووظفها توظيفا عمليا.
ولقد تبين لنا توظيفه لتلك الثقافة من خلال أحكامه الصادرة في قضايا النقض، مثل قضية فور بتاريخ 20 ماي 1963، أو من خلال تلك التي صدرت بالبت في منازعات الطعن بسبب تجاوز السلطة كقضايا بوتي جان، والحيحي محمد، وأحمد بن يوسف (19). ففي تلك القضايا، كانت عناية المجلس بتحديد الطبيعة القانونية للعقد، وقدم الحجة على تكييفه له، عن طريق إظهار اقتناعه بتوفر الشروط اللازمة الدالة على كينونته الإدارية، دون أن يتعداها الى صياغة نظرية فقهية أو استباقه بها. وكان مسلكه ذو طبيعة مهنية عملية، ابتغى بها تقديم الحجة المادية التي تبرر حكمه بالاختصاص القضائي. وقد جعل من طبيعة الوظيفة المسندة للأعوان المشار إليهم، والبنود المحددة لحقوقهم وواجباتهم باعتبارها شبيهة بما هو موجود في قانون الوظيفة العمومية، بنودا استثنائية تؤكد مشاركتهم في المرفق العمومي، ليأخذها كدليل على الطبيعة الإدارية للمنازعة (20).
إن مقاربته للعقد بخلفية ثقافية فرنسية كانت تؤشر الى تبنيه للتصور التقليدي في تعزيف العقد الإداري وتكييف المنازعة التعاقدية، غير أنه أسندها بمعيار موضوع الدعوى لإعلان اختصاصه بالنظر فيها، طالما أن القضاء الشامل لم يكن في مستطاعه استيعابها. وقد اشترط في البند الاستثنائي غير المألوف في العقود الخاصة، والمانح للاختصاص القضائي، أن يكون مطابقا للنظام العام، وهو ما أكد عليه في قضايا السيدة «بران» وسكوبا، وروني فيلا، والسيد كينان، وقضية (س) وشوفربي وكلانديني .(21). ويلاحظ أن المجلس الأعلى قد جعل من الطبيعة الإدارية للعقد في حكم الحيحي معيارا لاعتبار القرار الصادر بتنفيذه من جملة القرارات الإدارية القابلة للطعن فيها بالإلغاء، واعتبر السكرادي أن المعيار العضوي لا يكفي لاعتبار العقد من طبيعة إدارية.
الفقرة الثالثة : قضاء المجلس كمحكمة استئناف إدارية
يعتبر حكم المجلس الأعلى في قضية ابراهيم بولفروج في 21 شتنبر 1995 من بين أولى الأحكام، التي صدرت عنه بعد إحداث المحاكم الإدارية، وتصدت لمقاربة العقد الإداري.
فبعد أن الدور الذي ينبغي والقضاء الاضطلاع به في تمييز العقود الإدارية وغيرها من العقود، في ظل غياب معيار قانوني مستمد من المادة الثامنة ذكر بالمعايير التي يشترطها الفقه والقضاء فيها. وبعد إشارته الى ضرورة أن يكون أحد أطراف العقد شخصا معنويا عاما وأن يتضمن العقد نصوصا أو شروطا غير مألوفة في القانون العادي، أكد على توفر الشرطين المذكورين في النازلة المعروضة عليه، والمتعلقة بنزاع حول عقد يربط الطاعن بالمكتب الوطني للكهرباء بصفته مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري وصناعي. إلا أنه أضاف موضحا أنه إذا كان توفر الشرطين المذكورين ضروريا فقها لإضفاء صفة العقد الإداري عليه، إلا أن الفقه في نظره لا يكتفي بهما، بل يضيف عليهما كما استقر على ذلك الاجتهاد القضائي شرطا آخر ضروريا وأساسيا وهو أن يتعلق إبرام العقد بتسيير مرفق عام. ولما تبين له أن إبرام العقد لم يكن متعلقا بتسيير المرفق العام، قضى بعدم اعتباره عقدا إداريا رغم توفر الشرطين المذكورين فيه وبالتالي فإن النزاعات المتعلقة تخضع لاختصاص المحاكم الإدارية، وإنما لاختصاص محكمة القضاء الشامل على اعتبار أنه عقد عادي، ليس لكون إحدى المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري طرفا فيه، وإنما لعدم توفره على شرط أساسي وجوهري وهو تعلقه بتسيير مرفق عام، تم قضى بتأييد الأمر المستأنف. واشترط نفس الشروط الموضوعية في العقد المبرمة مع الشركة الوطنية لتجهيز خليج طنجة (24). فبعدما تحقق من أن الشركة بحكم خضوعها لوصاية وزارة السياحة قد تكلفت بتسيير مرفق عام، وأن العقد المبرمة تتوفر على شروط
وأخضعها لاختصاص المحاكم الإدارية طبقا للمادة الثامنة، ومؤيدا موقف المحكمة الإدارية بالرباط.
فالمجلس قارب العقد اعتمادا على العنصرين المكونين للمعيار المادي دون إعارة كبير اهتمام للمعيار العضوي، وهو ما يستفاد منه أنه يمكن للأشخاص الخاصة أن تبرم عقودا من طبيعة إدارية إذا تكلفت بمهمة المرفق العام وتمتعت بامتيازات السلطة العامة أو مارستها تحت وصايتها. ويعتبر هذا الموقف قريبا من حكم محكمة التنازع الفرنسية في قضية مؤسسة بيرو بتاريخ 8 يوليوز 1963.
واعتمد المجلس مقاربة ثلاثية المعايير في تكييفه للعقد المبرم بين علال شعالي والصندوق الوطني للقرض الفلاحي، ومما جاء في حكمه بتاريخ 9 نونبر 1995 (27) : وحيث إن مناط النزاع في النازلة هو معرفة طبيعة العقد الذي أبرم بين المستأنف المذكور والمستأنف عليه الصندوق الوطني للقرض الفلاحي، وهل هو عقد إداري يخضع النزاع المتعلق بتنفيذه للقضاء الإداري أم أن الأمر يتعلق بعقد عادي تختص به المحاكم ذات القضاء الشامل.
وحيث إذا الطرفان متفقين على توفر عنصرين من العناصر الثلاثة التي تميز العقود الإدارية عن العقود العادية على اعتبار أن أحد طرفي العقد شخص معنوي عام وأن العقد الذي أبرم بينه وبين المستأنف يتعلق بتسيير مرفق عام، فإن الخلاف قائم حول توفر أو عدم توفر العنصر الثالث أي توفر العقد أو عدم توفره على شروط غير مألوفة في العقود العادية.
وبعد تذكيره بحكم إدارية الرباط المطعون فيه التي عللت عدم اختصاصها بكون العقد لا يتضمن شروطا غير مألوفة في القانون الخاص، وبالتالي يرجع البت فيه الى محكمة الشغل رد عليه من خلال تفحصه للفصل 4 من العقد المبرم بين الطرفين، الذي اتضح أنه يخول لمدير الصندوق سلطة إنهاء التعاقد وإرجاع المتعاقد الى إدارته الأصلية، وهو شرط غير مألوف في العقود المدنية، يدل على أن الإدارة قد سلكت وسائل القانون العام في تعالمها مع المتعاقد معها، وانتهى الى اعتباره عقدا إدارية يرجع النظر في النزاعات المتعلقة بتنفيذه للمحكمة الإدارية، ومن ثم قضى بإلغاء الحكم المستأنف.
وذهب في حكمه بتاريخ 14 نونبر 1996 بمناسبة بته في طعن الاستئناف تقدمت به شركة كوجييرا ضد حكم محكمة مكناس الإدارية الى اعتبار الصفقة عقدا إداريا بنص القانون حيث قال (28) : وحيث يؤخذ من المرسوم المؤرخ في 1976/10/14 الذي نظم صفقات الأشغال العمومية والأدوات والخدمات المبرمة لحساب الإدارة العمومية أن الصفقة تعتبر عقدا إداريا بنص القانون الشيء الذي يعني أنه لا حاجة للبحث عن وجود شروط غير مألوفة في العقد المتعلق بها ليمكن القول بأن الأمر لا يتعلق بعقد في مجال القانون الخاص، كما لاحظت ذلك خطأ المحكمة الإدارية المطعون في حكمها عندما اعتبرت العقد موضوع النزاع غير عقد إداري بعلة عدم وجود شروط استثنائية غير مألوفة في مجال القانون الخاص، والحالة أن الأمر يتعلق كما أشير إليه بصفقة أبرمت الحساب الجماعة، فكان ذلك كافيا لإضفاء صبغة العقد الإداري عليها وبالتالي التصريح باختصاص المحكمة الإدارية للبت في الطلب». وكانت الصفقة المبرمة لحساب الجامعة مخصصة لسير مصلحة بيطرية تابعة لها.
فالمجلس اكتفى في هذه الحالة بالمزاوجة بين المعيار العضوي ومعيار المشاركة في تسيير المرفق العام لمقاربة العقد الإداري وتكييفه دون ما أن يرى حاجة الى توظيف معيار الشروط غير المألوفة، وهو ما يعني أنه أقر العمل بالمنهجية والمقاربة البدلية في إعماله لعناصر المعيار الموضوعي. غير أن صياغة حكمه شابها بعض اللبس، مما يدعو الباحث الى الاعتقاد بأنه اكتفى بالمعيار العضوي عندما قال بأن الصفقة أبرمت لحساب الجماعة فكان ذلك كافياه.
غير أنه سرعان ما عاد الى المقاربة الثلاثية في حكم له بتاريخ 20 فبراير 1996 صدر استثنافيا في قضية العون القضائي ضد فابيان.
وكانت المنازعة متصلة بصفقات الأشغال العمومية التي تعتبر مبدئيا من العقود الإدارية بتحديد قانوني، بدليل أن الفصل 52 من دفتر الشروط العامة قد أخضع المنازعات التي تنشأ بين المقاول والإدارة للمحاكم التي تنظر في المادة الإدارية (30). ومما جاء في حكم المجلس الأعلى أنه إذا كان ينبغي حسب الاجتهاد أن تتوفر في العقود الإدارية ثلاثة شروط لإخضاعها للقانون العام وبدونها تعتبر من العقود المدنية، فإن عقد الأشغال العامة باعتباره اتفاقا بين المقاول والإدارة للقيام بتنفيذ أشغال البناء وترميم وصيانة البنايات والبنية العقارية لفائدة أحد الأشخاص العمومية بغرض تحقيق المصلحة العامة، إنما يعتبر من العقود الإدارية بتحديد من القانون. هذه الحالة، انطلق المجلس في تأسيسه النظري، من مقاربة شمولية وشاملة لينتهي في قضية الحال الى المزاوجة بين المعيار العضوي ومعيار تنفيذ المرفق العام لاعتبار الصفقة عقدا إداريا بتحديد القانون، وهو تحصيل حاصل لا يحتاج الى برهان ويدخل في باب توضيح الواضحات.
وتوضيحا لمفهوم الصفقة وعناصرها ومقوماتها الأساسية قضى المجلس في قضية حامد زريكم بتاريخ 18 يونيو 1998، بأنه مما ولا جدال فيه أن الصفقة العمومية إذا كانت فعلا تعتبر عقدا إداريا بنص القانون فإن ذلك يتوقف أولا وأخيرا على وجوب توفر عناصر الصفقة العمومية أي أن تقوم الإدارة المعنية بالأمر بفتح باب المناقصة أو المزايدة ليفوز من يعنيه الأمر بالصفقة المذكورة….. وبعد دراسته للنازلة، تبين له أن العقد المبرمة كانت في إطار القانون الخاص وعن طريق سندات الطلب التي استثناها الفصل 51 من مرسوم 14 أكتوبر 1976 من الخضوع لمقتضيات المرسوم وهي لا تتوفر فيها شروط الصفقة العمومية، مما يجعلها مندرجة ضمن اختصاص القضاء العادي