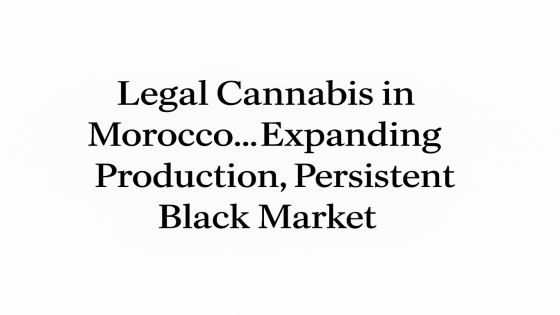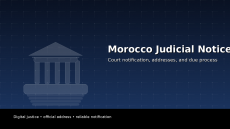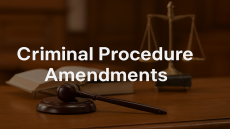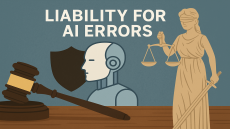أقترح أن أحلل معكم فكرة تبدو واضحة للوهلة الأولى، لكنها تنطوي على أخطر أنواع سوء الفهم. أشكال المجتمع البشري متنوعة للغاية. هناك التجمّعات البشرية الكبرى مثل الصين، مصر، وبابل القديمة؛ القبيلة كما لدى العبرانيين والعرب؛ المدينة كما في أثينا وسبارتا؛ اتحادات بلدان متعددة كما في الإمبراطورية الكارولنجية؛ الجماعات التي بلا وطن وتحافظ على تماسكها من خلال الرابط الديني، مثل اليهود والبارسيين؛ الأمم مثل فرنسا، إنجلترا ومعظم الكيانات الأوروبية الحديثة ذات الاستقلال الذاتي؛ الكونفدراليات كما في سويسرا وأمريكا؛ والروابط القائمة على القرابة التي تؤسسها اللغة، لا العرق، بين مختلف فروع الجرمان أو السلاف؛ كل هذه أشكال من التجمّع موجودة أو كانت موجودة، ولا ينبغي الخلط بينها دون عواقب خطيرة.
في زمن الثورة الفرنسية، كان يُعتقد أن مؤسسات المدن الصغيرة المستقلة مثل سبارتا وروما يمكن تطبيقها على الأمم الكبرى التي تضم ثلاثين إلى أربعين مليون نسمة. أما اليوم، فإننا نرتكب خطأً أكثر جسامة: نخلط بين العرق والأمة، ونعزو إلى مجموعات إثنوغرافية – أو بالأحرى لغوية – سيادةً شبيهة بتلك التي تملكها الشعوب الموجودة فعليًا. دعونا نحاول الوصول إلى بعض الدقة في هذه القضايا المعقدة، حيث إن أي التباس في معنى الكلمات في بداية التفكير قد يؤدي في النهاية إلى أخطاء كارثية. ما نحن بصدد القيام به حساس للغاية؛ هو أشبه بالتشريح الحي؛ سنتعامل مع الأحياء كما نعامل الأموات عادة. وسنقوم بذلك بكل برودة أعصاب، وبمنتهى الحيادية.
I:منذ سقوط الإمبراطورية الرومانية، أو بالأحرى منذ تفكك إمبراطورية شارلمان،
تبدو لنا أوروبا الغربية منقسمة إلى أمم، حاولت بعضها في فترات معينة فرض الهيمنة على غيرها، لكنها لم تنجح قط بشكل دائم. ما لم ينجزه شارل الخامس، ولا لويس الرابع عشر، ولا نابليون الأول، لن يستطيع أحد إنجازه في المستقبل. لقد أصبح تأسيس إمبراطورية رومانية جديدة أو إعادة بعث إمبراطورية شارلمان أمرًا مستحيلاً. لقد أصبح تقسيم أوروبا أمرًا بالغ الرسوخ، بحيث إن أي محاولة للهيمنة العالمية ستقابل بسرعة كبيرة بتحالف يُعيد الأمة الطامعة إلى حدودها الطبيعية. لقد ترسخ نوع من التوازن طويل الأمد. ستبقى فرنسا، إنجلترا، ألمانيا، وروسيا – رغم كل المغامرات التي قد تخوضها – شخصيات تاريخية قائمة، قطعًا أساسية في رقعة شطرنج تتغير فيها أهمية المربعات وحجمها باستمرار، لكنها لا تندمج أبدًا بشكل كامل.
الأمم، بهذا المعنى، هي شيء جديد نسبيًا في التاريخ. لم تعرفها العصور القديمة؛ فمصر، الصين، وبابل القديمة لم تكن أممًا بأي شكل من الأشكال. كانت قطعانًا يقودها ابن الشمس أو ابن السماء. لم يكن هناك مواطنون مصريون، تمامًا كما لا يوجد مواطنون صينيون. لقد شهدت العصور القديمة جمهوريات وملكيات بلدية، واتحادات من جمهوريات محلية، وإمبراطوريات؛ لكنها لم تعرف الأمة بالمعنى الذي نفهمه اليوم. كانت أثينا، سبارتا، صيدون، وصور مراكز صغيرة لوطنية رائعة؛ لكنها كانت مدنًا ذات أراضٍ محدودة. كانت بلاد الغال، إسبانيا، وإيطاليا، قبل امتصاصها داخل الإمبراطورية الرومانية، مجموعات من القبائل غالبًا ما تكون متحالفة، لكنها من دون مؤسسات مركزية أو سلالات حاكمة. ولم تكن الإمبراطوريات الآشورية، الفارسية، أو إمبراطورية الإسكندر أوطانًا كذلك.
لم تكن إمبراطورية الإسكندر أيضًا وطنًا. لم يوجد قط وطنيون آشوريون؛ أما الإمبراطورية الفارسية، فكانت إقطاعية شاسعة. لم تكن…
لم تربط أي أمة أصولها بالمغامرة الجبارة التي خاضها الإسكندر، رغم ما كان لها من أثر عظيم على مجرى التاريخ العام للحضارة.
لقد كانت الإمبراطورية الرومانية أقرب بكثير إلى أن تُعدّ وطناً. فقد كانت، مقابل الفضل العظيم المتمثل في إنهاء الحروب، محبوبة رغم قسوتها الأولى. لقد كانت اتحاداً عظيماً، مرادفاً للنظام، والسلام، والحضارة. وفي أواخر عهد الإمبراطورية، نشأ عند النفوس السامية، وعند الأساقفة المتنورين، وعند أهل الأدب، شعور حقيقي بـ”السلام الروماني” الذي كان يُقابل الفوضى المهددة بالقدوم من البربرية.
لكن، إمبراطورية تبلغ اثني عشر ضعف مساحة فرنسا الحالية لا يمكن أن تُكوّن دولةً بالمعنى الحديث للكلمة. وكان انقسام الشرق والغرب أمراً حتمياً. ولم تنجح المحاولات التي أُجريت في القرن الثالث لتأسيس إمبراطورية غالية. إن الغزو الجرماني هو الذي أدخل إلى العالم المبدأ الذي أصبح لاحقاً أساساً لوجود الجنسيات.
فما الذي فعله الشعوب الجرمانية، في الواقع، منذ اجتياحاتهم الكبرى في القرن الخامس إلى آخر الفتوحات النورماندية في القرن العاشر؟ لم يغيروا كثيراً في أصل الأعراق؛ لكنهم فرضوا سلالات حاكمة وأرستقراطيات عسكرية على أجزاء من الإمبراطورية الغربية القديمة، والتي اتخذت أسماء غزاتها. ومن هنا ظهرت فرنسا، وبورغونيا، ولومبارديا؛ ولاحقاً، نورمانديا. وقد أعاد الصعود السريع للإمبراطورية الفرنجية الوحدة للغرب لفترة وجيزة؛ لكنها انهارت بشكل لا رجعة فيه في منتصف القرن التاسع، حيث رسمت معاهدة فردان حدوداً ثابتة من حيث المبدأ، ومنذ ذلك الحين بدأت فرنسا، وألمانيا، وإنجلترا، وإيطاليا، وإسبانيا تسير، عبر طرق غالباً ما كانت ملتوية وعبر مغامرات شتى، نحو اكتمال وجودها الوطني، كما نراه متفتحاً اليوم.
ما الذي يميز، في الواقع، هذه الدول المختلفة؟ إنه اندماج السكان الذين تتألف منهم. ففي البلدان التي عددناها، لا يوجد شيء مشابه لما تجده في تركيا، حيث لا يزال التركي، والسلافي، واليوناني، والأرمني، والعربي، والسوري، والكردي متميزين اليوم كما كانوا يوم الغزو.
ساهم عاملان أساسيان في هذا الاندماج:
أولاً،
تبني الشعوب الجرمانية للمسيحية فور شروعها في علاقات دائمة بعض الشيء مع الشعوب اليونانية واللاتينية. فعندما يكون الغالب والمغلوب من نفس الديانة، أو بالأحرى، عندما يتبنى الغالب ديانة المغلوب، فإن النظام التركي، القائم على التمييز التام بين الناس على أساس الدين، لا يمكن أن يتحقق.
ثانياً،
نسيان الغزاة للغتهم الأصلية. فقد كان أحفاد كلوفيس، وألارك، وغوندوبالد، وألبوين، ورولون يتحدثون الرومانية بالفعل. وكان هذا بحد ذاته نتيجة لميزة مهمة أخرى: أن الفرنكيين، والبرغنديين، والقوط، واللومبارديين، والنورمان، جاءوا ومعهم عدد قليل جداً من نساء أعراقهم. ولم يتزوج القادة في الأجيال الأولى إلا من نساء جرمانيات؛ لكن عشيقاتهم كنّ لاتينيات، ومربيات أطفالهم كنّ لاتينيات، وكل القبيلة كانت تتزوج من نساء لاتينيات؛ وبهذا لم يكن للغة الفرنكية أو القوطية مصير طويل منذ استقرار تلك الشعوب في الأراضي الرومانية.
لم يكن الحال كذلك في إنجلترا؛ إذ جاءت الغزوات الأنجلوساكسونية على الأرجح برفقة نساء، وفر السكان البريطانيون، وكان اللاتيني قد اندثر أو لم يكن سائداً قط في بريطانيا. ولو كانت الغالية تُستخدم على نطاق واسع في بلاد الغال في القرن الخامس، لما تخلّى كلوفيس وأتباعه عن الجرمانية لصالح الغالية.
ومن هنا جاء هذا الأثر الحاسم: على الرغم من عنف طباع الغزاة الجرمانيين الشديد، فإن الإطار الذي فرضوه أصبح، مع مرور الزمن، هو ذاته الإطار الذي تشكلت فيه الأمة. فأصبح من المشروع تماماً أن يُطلق اسم فرنسا على بلد لم تدخل إليه سوى أقلية لا تُذكر من الفرنكيين.
وفي القرن العاشر، في أولى أناشيد الملاحم (chansons de geste)، التي تعكس بصدق روح العصر، كان جميع سكان فرنسا يُعدّون فرنسيين. وفكرة وجود اختلاف عرقي بين سكان فرنسا، التي كانت واضحة عند غريغوار دي تور، لا تظهر على الإطلاق في كتابات وأشعار الفرنسيين بعد عهد هيو كابيه. وكان الفارق بين النبيل والعامي بارزاً جداً؛ لكنه لم يكن فرقاً إثنياً بأي حال، بل فرقاً في الشجاعة والعادات والتعليم الموروث؛ ولم يكن يخطر ببال أحد أن أصل هذا كله هو الغزو. والنظرية الخاطئة التي تقول إن النبل نشأ من امتياز منحه الملك لقاء خدمات عظيمة…
كل نبيل إذن هو شخص تم ترفيعه إلى مرتبة النبلاء، وهذا النظام قد استُقرّ عليه كعقيدة منذ القرن الثالث عشر. وقد حدث الأمر ذاته تقريباً بعد معظم الفتوحات النورماندية. فبعد جيل أو جيلين، لم يعد الغزاة النورمان يتميزون عن بقية السكان؛ ومع ذلك، فقد كانت تأثيراتهم عميقة؛ إذ منحوا البلاد التي غزوها أرستقراطية، وعادات عسكرية، ووطنية لم تكن موجودة من قبل.
النسيان، بل وحتى الخطأ التاريخي، عنصر أساسي في تكوين الأمة؛ ولهذا فإن تقدم الدراسات التاريخية يشكل في كثير من الأحيان خطراً على الحس الوطني. فالبحث التاريخي يعيد إلى الواجهة وقائع العنف التي صاحبت نشأة التكوينات السياسية، حتى تلك التي كانت نتائجها لاحقاً من أكثر النتائج نفعاً. فالوحدة دائمًا ما تُبنى بوحشية؛ فقد كانت وحدة فرنسا الشمالية وفرنسا الجنوبية نتيجة للإبادة وللرعب المستمر لما يقارب القرن.
الملك الفرنسي، الذي هو، إن صحّ التعبير، المثال المثالي “للمبلور التاريخي” على مدى قرون؛ الملك الذي أوجد أكمل وحدة وطنية عرفها التاريخ؛ هذا الملك، حين يُنظر إليه عن كثب، يفقد بريقه؛ والأمة التي شكّلها قد لعنته، واليوم، لم يعد يعرف قيمته وما فعله إلا المثقفون.
تظهر هذه القوانين الكبرى في تاريخ أوروبا الغربية بجلاء من خلال التباين. فالمشروع الذي أنجزه الملك الفرنسي — بقسط من طغيانه وبقسط من عدله — قد فشل فيه كثير من البلدان. تحت تاج القديس ستيفان، بقي المجريون والسلافيون متميزين كما كانوا قبل ثمانمئة عام. أما آل هابسبورغ، فقد أبقوا شعوبهم منفصلة، بل وغالباً في خصام. وفي بوهيميا، كان العنصر التشيكي والعنصر الألماني متجاورين كما الزيت والماء في كأس واحدة.
أما السياسة التركية، القائمة على الفصل بين القوميات حسب الدين، فقد كانت لها نتائج أكثر كارثية: لقد تسببت في انهيار الشرق. خذ مثلاً مدينة كسالونيك أو إزمير، تجد فيها خمس أو ست جماعات، لكل واحدة منها ذاكرتها الخاصة، ولا يوجد بينها ما يجمعها تقريباً.
والحال أن جوهر الأمة هو أن يشترك كل الأفراد في أشياء كثيرة، وأن ينسوا كثيراً من الأشياء في الوقت نفسه. فلا يوجد فرنسي يعرف إن كان بورغنديًا أو ألانيًا أو تايفاليًا أو قوطيًا غربيًا؛ وكل فرنسي يجب أن يكون قد نسي مذبحة سان بارتيليمي، ومجازر الجنوب في القرن الثالث عشر. لا توجد في فرنسا عشر عائلات يمكنها إثبات أصلها الفرنكي، وحتى لو وُجدت، فإن مثل هذا الإثبات سيكون معيباً جوهرياً، بسبب آلاف التزاوجات المجهولة التي تخلط كل الحسابات التي يعتمدها النسبيون.
إن الأمة الحديثة هي إذًا نتيجة تاريخية، ناتجة عن سلسلة من الوقائع التي تتقارب نحو اتجاه واحد. فحيناً تحقق الوحدة بواسطة سلالة حاكمة، كما هو الحال في فرنسا؛ وحيناً آخر عبر الإرادة المباشرة للأقاليم، كما في هولندا وسويسرا وبلجيكا؛ أو بفعل روح عامة انتصرت أخيراً على تقلبات الإقطاع، كما في إيطاليا وألمانيا. وفي كل الحالات، كانت هناك دوماً أسباب وجود عميقة تقف خلف هذه التكوينات.
تظهر المبادئ، في مثل هذه السياقات، من خلال مفاجآت غير متوقعة. لقد رأينا في أيامنا هذه كيف توحدت إيطاليا بهزائمها، وكيف انهارت تركيا بانتصاراتها. فكل هزيمة قرّبت إيطاليا من هدفها؛ وكل نصر عجّل بانهيار تركيا؛ لأن إيطاليا أمة، أما تركيا — باستثناء آسيا الصغرى — فليست أمة.
ومفخرة فرنسا أنها، عبر الثورة الفرنسية، أعلنت أن الأمة موجودة بذاتها. ولا ينبغي لنا أن نغضب من أن تُقلّد في ذلك. فمبدأ القوميات هو مبدؤنا.
لكن، ما الأمة إذن؟
لماذا تُعدّ هولندا أمة، بينما لا يُعدّ هانوفر أو دوقية بارما أمة؟ كيف تستمر فرنسا في كونها أمة، بينما زال المبدأ الذي أنشأها؟ كيف تكون سويسرا — التي تضم ثلاث لغات، ودينين، وثلاث أو أربع أعراق — أمة، بينما لا تُعدّ توسكانا، رغم تجانسها الشديد، أمة؟ لماذا تُعدّ النمسا دولةً لا أمة؟
بمَ يختلف مبدأ القوميات عن مبدأ الأعراق؟
هذه أسئلة يحرص الذهن المتأمل على أن يجد لها جوابًا، ليكون على وفاق مع نفسه.
فشؤون العالم لا تُدار غالباً بهذه الأنواع من التحليلات؛ لكن العقول المتعمقة تطمح إلى إدخال شيء من العقل في هذه الأمور، وفكّ التشابكات التي يتعثر فيها السطحيون.
بالاستماع إلى بعض المنظرين السياسيين، نجد أن الأمة، قبل كل شيء، هي سلالة حاكمة، تمثل غزوًا قديمًا، غزوًا تم قبوله في البداية، ثم نسيه عامة الشعب. وبحسب هؤلاء السياسيين، فإن توحيد المقاطعات الذي قامت به سلالة حاكمة — من خلال الحروب، والزواج، والمعاهدات — ينتهي بزوال تلك السلالة. ومن الصحيح أن معظم الأمم الحديثة قد أنشأتها عائلة من أصل إقطاعي، تزاوجت مع الأرض، وكانت بمثابة نواة مركزية للوحدة. فحدود فرنسا في عام 1789 لم تكن طبيعية ولا ضرورية. فالمناطق الواسعة التي أضافها آل كابيتي إلى الشريط الضيق الناتج عن معاهدة فردان كانت بالفعل مكاسب شخصية لهذه الأسرة. وفي زمن تلك الإلحاقات، لم تكن هناك فكرة عن الحدود الطبيعية، ولا عن حق الأمم، ولا عن إرادة المقاطعات. وكذلك فإن اتحاد إنجلترا وإيرلندا واسكتلندا كان حدثًا سلاليًا (ديناستيًا). أما إيطاليا، فلم تتأخر كل هذا الوقت لتصبح أمة إلا لأنه، من بين بيوتها الحاكمة العديدة، لم تتخذ أيٌّ منها مركزًا للوحدة قبل هذا القرن. ومن الغريب أن تلك الأمة قد اتخذت لقبها الملكي من جزيرة سردينيا الغامضة، وهي أرض بالكاد تُعدّ إيطالية. أما هولندا، التي أنشأت نفسها بنفسها بفعل قرار بطولي، فقد عقدت مع ذلك زواجًا وثيقًا مع بيت أورانج، وستكون مهددة فعلاً في اليوم الذي تُفك فيه هذه الوحدة.
لكن، هل هذا القانون مطلق؟
بالتأكيد لا. فسويسرا والولايات المتحدة، اللتان تشكلتا كمزيج من إضافات متتالية، لا تستندان إلى أي قاعدة سلالية. ولن أناقش المسألة فيما يتعلق بفرنسا؛ إذ يتطلب ذلك معرفة سر المستقبل. لنقل فقط إن تلك الملكية الفرنسية العظيمة كانت وطنية إلى درجة أنه، في اليوم التالي لسقوطها، استطاعت الأمة الاستمرار بدونها. ثم إن القرن الثامن عشر قد غيّر كل شيء؛ إذ عاد الإنسان، بعد قرون من الانحطاط، إلى الروح القديمة، إلى احترام ذاته، وإلى فكرة حقوقه. وقد استعادت كلمات “الوطن” و”المواطن” معناها. وهكذا تم إنجاز أجرأ عملية في التاريخ، يمكن مقارنتها، في علم وظائف الأعضاء، بمحاولة إبقاء جسد على قيد الحياة بعد إزالة دماغه وقلبه.
يجب إذًا الإقرار بأن الأمة يمكن أن توجد بدون مبدأ سلالي، بل ويمكن لأممٍ تشكلت عبر سلالات أن تنفصل عن تلك السلالات دون أن تفقد وجودها. فلم يعد بالإمكان التمسك بالمبدأ القديم الذي لا يعترف إلا بحقوق الأمراء؛ فهناك، إلى جانب الحق السلالي، حق وطني. ولكن على أي معيار يمكن تأسيس هذا الحق الوطني؟ وبأي علامة نميزه؟ ومن أي واقع ملموس نشتقه؟
يجيب البعض بثقة: من العِرق (العرقية). فالتقسيمات المصطنعة الناتجة عن الإقطاع، وزيجات الأمراء، ومؤتمرات الدبلوماسيين أصبحت بالية. وما يبقى ثابتًا هو عِرق الشعوب. وهذا ما يُشكل حقًا وشرعية. فالعائلة الجرمانية، على سبيل المثال، بحسب النظرية التي أشرحها، لها الحق في استعادة الأعضاء المتناثرين من الجرمانية، حتى عندما لا يرغب هؤلاء الأعضاء في الانضمام. وبهذا يصبح “حق الجرمانية” في إقليمٍ ما أقوى من حق سكان ذلك الإقليم في تقرير مصيرهم بأنفسهم. ويؤدي هذا إلى إنشاء نوع من “الحق الأولي” شبيه بذلك الذي كان للملوك بحقهم الإلهي؛ إذ يُستبدل مبدأ الأمم بمبدأ الإثنولوجيا (علم الأعراق). وهذا خطأ جسيم، وإذا ما أصبح سائدًا، فسيفضي إلى تدمير الحضارة الأوروبية. فبقدر ما مبدأ الأمم عادل وشرعي، فإن مبدأ الحق الأولي للعرق ضيق وخطير على التقدم الحقيقي.
صحيح أنه في القبيلة والمدينة القديمة كان للعنصر العرقي أهمية من الدرجة الأولى. فالقبيلة والمدينة القديمة لم تكونا إلا امتدادًا للعائلة. ففي إسبرطة وأثينا، كان جميع المواطنين أقرباء بدرجات متفاوتة. وكذلك كان الحال بين بني إسرائيل؛ ولا يزال الأمر كذلك في القبائل العربية. ولكن إذا انتقلنا من أثينا، وإسبرطة، والقبيلة الإسرائيلية إلى الإمبراطورية الرومانية، فإن الوضع مختلف تمامًا. فقد تشكلت في البداية بالقوة، ثم استمرت بفعل المصلحة، وكانت هذه الكتلة الضخمة من المدن والمقاطعات المختلفة كليًّا بمثابة ضربة قاضية لفكرة العِرق. وجاء المسيحية، بطابعها العالمي والمطلق، لتعزز هذا الاتجاه بشكل أعمق.
…إنه نتيجة كل ذلك. الفرنسي ليس غاليًا، ولا فرانكيًا، ولا بورغنديًا؛ بل هو حاصل تراكمي لكل هذه العناصر.
لقد أقام الرومان، عبر إمبراطوريتهم، تحالفًا وثيقًا مع المسيحية، وبفضل هذين العاملين الفريدين في توحيد الشعوب، تم استبعاد الاعتبار الإثنوغرافي (العرقي) من إدارة الشؤون الإنسانية لعدة قرون.
حتى غزو البرابرة، على الرغم من ظاهره، شكّل خطوة إضافية في هذا الاتجاه. فالتقسيمات التي أحدثتها الممالك البربرية لم تكن إثنية بأي حال؛ بل كانت نتيجة للقوة أو مزاج الغزاة. وكانت أعراق الشعوب التي خضعوا لها لا تعني لهم شيئًا. شارلمان أعاد، على طريقته، ما أنجزته روما من قبل: إمبراطورية موحدة تضم أعراقًا شديدة التنوع. أما واضعو معاهدة فردان، عندما رسموا خطيهم الرئيسيين من الشمال إلى الجنوب، فلم يلقوا أي اعتبار للأعراق التي وُجدت على اليمين أو اليسار من تلك الخطوط. حتى التحولات الحدودية التي حدثت لاحقًا في العصور الوسطى لم تراعِ أية توجهات إثنية.
وإذا كانت السياسة التي اتبعتها أسرة الكابيتيين قد نجحت في جمع أراضي الغال القديمة تقريبًا تحت اسم “فرنسا”، فإن هذا لم يكن ناتجًا عن ميل فطري لدى تلك المناطق للاتحاد مع نظيراتها. فالدوفينيه، والبريس، والبروفانس، والفرانش-كومتي لم تكن تتذكر أي أصل مشترك. وكل شعور بالهوية الغالية قد اندثر منذ القرن الثاني للميلاد، وليس إلا بجهود العلماء، في أيامنا هذه، أننا أعدنا اكتشاف الشخصية الغالية بشكل استعادي.
وبالتالي، لم تلعب الاعتبارات الإثنية أي دور في تشكيل الأمم الحديثة. ففرنسا مزيج من العنصر الكلتي، والإيبيري، والجرماني. وألمانيا تضم عناصر جرمانية، وكلتية، وسلافية. أما إيطاليا، فهي البلد الذي يربك فيه علم الأعراق أكثر من غيره؛ إذ تتقاطع فيه عناصر غالية، وإترورية، وبلاسجية، ويونانية، ناهيك عن العديد من المكونات الأخرى في خليط لا يمكن تفكيكه. أما الجزر البريطانية، فإنها تقدم مزيجًا من الدم الكلتي والجرماني، بنسب يصعب تحديدها بدقة.
والحقيقة هي أنه لا توجد “عرق نقي”، وأن بناء السياسات على التحليل الإثنوغرافي إنما هو تأسيسها على وهم. فأكثر البلدان نبلًا، كإنجلترا، وفرنسا، وإيطاليا، هي تلك التي تمتزج فيها الدماء أكثر من غيرها. وهل تشكل ألمانيا استثناءً في هذا السياق؟ هل هي بلد “جرماني خالص”؟ يا لها من أوهام! فالجنوب بأكمله كان غاليًا، والشرق بكامله، انطلاقًا من نهر إلبه، كان سلافيًا. وحتى الأجزاء التي يُظن أنها “نقية” من العنصر الجرماني، هل هي كذلك حقًا؟ نحن هنا أمام إحدى المسائل التي من المهم للغاية أن نكوّن فيها أفكارًا واضحة ونمنع سوء الفهم.
فالجدل حول الأعراق لا ينتهي، لأن كلمة “عرق” تُستخدم بمعنيين مختلفين تمامًا من قِبل المؤرخين اللغويين من جهة، والأنثروبولوجيين من جهة أخرى. فعند الأنثروبولوجيين، تعني “العرق” كما في علم الحيوان: أي نسب حقيقي، وقرابة بالدم. لكن دراسة اللغات والتاريخ لا تؤدي إلى التقسيمات نفسها التي تعتمدها الفسيولوجيا. فمصطلحات مثل “قصير الرأس” و”طويل الرأس” (براكيكيفال ودوليكوسيفال) لا مكان لها في التاريخ أو الفيلولوجيا. ففي الجماعة البشرية التي خلقت اللغات والنظام الآري، كان هناك بالفعل قصيرو الرؤوس وطويلوها. وينطبق الأمر نفسه على الجماعة الأصلية التي أنتجت ما يُعرف باللغات والمؤسسات السامية.
بمعنى آخر، فإن الأصول الحيوانية للإنسان أقدم بكثير من بدايات الثقافة، والحضارة، واللغة. فالمجموعات “الآرية الأصلية” و”السامية الأصلية” و”الطورانية الأصلية” لم تكن لها وحدة بيولوجية. فهذه التكتلات هي ظواهر تاريخية وقعت في فترة ما، لنقل قبل خمسة عشر إلى عشرين ألف سنة، بينما تعود الأصول الحيوانية للإنسان إلى عصور غامضة لا يمكن قياسها. وما يُسمى، من منظور لغوي وتاريخي، “العرق الجرماني” هو بالتأكيد عائلة متميزة داخل النوع البشري. ولكن هل هي عائلة بالمعنى الأنثروبولوجي؟ لا، بالتأكيد لا.
فبروز الشخصية الجرمانية في التاريخ لم يتم إلا قبل قرون قليلة من الميلاد. ومن غير المرجح أن يكون الجرمان قد خرجوا من باطن الأرض في تلك اللحظة؛ بل إنهم، قبل ذلك، كانوا مندمجين مع السلاف في الكتلة الغامضة الكبرى المسماة السكيثيين، ولم تكن لهم هوية منفصلة.
فالبريطاني المعاصر هو نموذج إنساني متفرد، ولكن ما يُسمى ـ على نحو غير دقيق ـ “العرق الأنجلوساكسوني” ليس هو البريتون في عهد قيصر، ولا الأنجلوساكسوني في زمن هينغست، ولا الدنماركي في زمن كنوت، ولا النورماندي في عهد ويليام الفاتح؛ بل هو حصيلة كل هؤلاء.
…سادتهم. إذًا، حتى في البدايات، لم تكن وحدة اللغة تعني وحدة العرق.
إن الذي خرج من “المرجل الكبير”، حيث تفاعلت، تحت إشراف ملك فرنسا، أكثر العناصر تنوعًا، هو النموذج الذي يكوّن “الفرنسي” الحديث. فمثلاً، لا يختلف سكان جيرزي أو غيرنزي في أصولهم عن سكان نورماندي في الساحل المقابل. في القرن الحادي عشر، لم يكن بالإمكان حتى لأدق العيون تمييز أي فرق بين الجانبين من القناة. فقط ظروف طفيفة جعلت فيليب أوجست لا يضم تلك الجزر مع باقي نورماندي. وبفعل سبعة قرون من الانفصال، أصبح سكان المنطقتين غرباء، بل مختلفين تمامًا عن بعضهم البعض. وبالتالي، فـ”العرق”، كما يفهمه المؤرخون، هو شيء يتشكل ويتلاشى.
إن دراسة العرق مهمة جدًا للباحث في تاريخ البشرية، لكنها لا تصلح أساسًا للسياسة. إن الحدس الغريزي الذي ساهم في رسم خريطة أوروبا لم يأخذ العرق بعين الاعتبار، وأكبر الأمم الأوروبية هي أمم مختلطة الدماء.
ومن ثم فإن أهمية العنصر العرقي، رغم كونها كانت جوهرية في الأصل، تتناقص باستمرار. فالتاريخ الإنساني يختلف جوهريًا عن علم الحيوان. فالعرق ليس كل شيء كما هو الحال عند القوارض أو السنوريات، وليس من حق أحد أن يذرع العالم قارئًا جماجم الناس، ثم ينقض عليهم قائلاً: «أنت من دمنا، إذن أنت ملك لنا!». فإلى جانب الخصائص الأنثروبولوجية، هناك العقل، والعدالة، والحقيقة، والجمال، وهي أمور مشتركة بين الجميع.
ثم إن هذه السياسة الإثنوغرافية غير آمنة. فاليوم تستغلها ضد الآخرين، وغدًا قد تُستخدم ضدك. وهل من المؤكد أن الألمان، الذين رفعوا راية الإثنوغرافيا عاليًا، لن يجدوا أنفسهم في مواجهة السلافيين وهم يحللون أسماء القرى في ساكسونيا ولوساتيا، ويبحثون عن آثار الويليتس أو الأوبوتريتس، ويطالبون بمحاسبة مجازر وعمليات بيع جماعية ارتكبها الأوثونيون بحق أسلافهم؟ من الأفضل للجميع أن يتعلموا النسيان.
أنا أحب الإثنوغرافيا، فهي علم غاية في الإثارة، لكن، لأني أريدها حرة، فلا أريد لها أي تطبيق سياسي. وكما هو الحال في جميع العلوم، تتغير الأنظمة في الإثنوغرافيا؛ وهذا هو شرط التقدم. وإذا كانت حدود الدول ستتبع تقلبات العلم، فإن الوطنية ستعتمد على أطروحة قد تكون صحيحة أو متناقضة. فيُقال للمواطن: “لقد أخطأت؛ لقد ضحّيت بنفسك من أجل قضية؛ كنت تظن أنك كلتي؛ لا، أنت جرماني”. وبعد عشر سنوات، يُقال له إنه سلافي. ولألا يُشوّه العلم، فلنُعفه من إبداء رأيه في هذه القضايا، التي تنطوي على مصالح كثيرة. وتأكدوا أنه إذا تم تكليف العلم بتقديم عناصر تُستخدم في الدبلوماسية، فسوف يُضبط مرارًا وهو يرتكب المجاملة عن غير قصد. لديه ما هو أفضل ليقدمه: فلنطلب منه الحقيقة فقط.
II. ومثلما قلنا عن العرق، ينبغي أن نقوله عن اللغة.
فاللغة تُشجع على الوحدة، لكنها لا تفرضها. الولايات المتحدة وإنجلترا، وأمريكا الناطقة بالإسبانية وإسبانيا، يتحدثون نفس اللغة، لكنهم لا يشكلون أمة واحدة. وعلى العكس، نجد أن سويسرا، التي تشكلت بأفضل طريقة ممكنة نتيجة لموافقة أجزائها المختلفة، تضم ثلاث أو أربع لغات. ففي الإنسان، هناك شيء أسمى من اللغة: إنها الإرادة. إرادة سويسرا في أن تبقى موحدة، رغم تنوع لغاتها، هي أمر أكثر أهمية من التشابه اللغوي الذي يُفرض أحيانًا من خلال الإكراه.
ومن المفاخر التي تُحسب لفرنسا أنها لم تسعَ أبدًا إلى فرض وحدة اللغة بوسائل قسرية. أفلا يمكن أن نحمل المشاعر نفسها، والأفكار نفسها، ونحب نفس الأشياء بلغات مختلفة؟
تحدثنا قبل قليل عن الخطر المتمثل في جعل السياسة الدولية تعتمد على الإثنوغرافيا. وليس هناك ضرر أقل من أن نجعلها تعتمد على الفيلولوجيا المقارنة. فلنترك لهذه الدراسات الشيقة حرية نقاشاتها الكاملة؛ ولا نخلطها بما قد يُفسد صفاءها. إن الأهمية السياسية التي تُمنح للغات تعود إلى الاعتقاد بأنها علامات على العرق. وهذا خطأ فادح. فبروسيا، التي لا يُتحدث فيها اليوم إلا الألمانية، كانت تتحدث السلافية قبل بضعة قرون؛ ويلز تتحدث الإنجليزية؛ الغال وإسبانيا يتحدثون لغة ألبا لونغا القديمة؛ مصر تتحدث العربية. والأمثلة لا تُحصى.
وحتى في البدايات، لم تكن وحدة اللغة تعني وحدة العرق. لنأخذ القبيلة الآرية الأولى أو السامية الأولى؛ كان هناك عبيد ضمنها، يتحدثون نفس لغة أسيادهم…
…التركيب الوطني. ومع ذلك، لا تكفي الجغرافيا وحدها لإنشاء أمة.
فلنعد إلى البداية:
كان العبد، في كثير من الأحيان، ينتمي إلى عرق مختلف عن عرق سيده. ولنكرر القول: هذه التقسيمات اللغوية — الهندوأوروبية، السامية، وغيرها — التي أنشأتها الفيلولوجيا المقارنة بذكاء باهر، لا تتطابق مع التقسيمات الأنثروبولوجية. فاللغات هي تكوينات تاريخية، تشير إلى القليل جدًا عن دم من يتحدث بها، وهي — على أي حال — لا يمكن أن تقيد حرية الإنسان حين يتعلق الأمر باختيار العائلة أو المجموعة التي يريد أن يرتبط بها مدى الحياة والموت.
إن التركيز الحصري على اللغة، مثل التركيز المفرط على العرق، ينطوي على مخاطر ومساوئ. عندما يذهب أحدهم في ذلك إلى المبالغة، ينغلق داخل ثقافة معينة يعتبرها قومية؛ فيضع لنفسه حدودًا، ويحبس نفسه. يترك الهواء النقي الذي يُتنفس في الفضاء الإنساني الواسع، ليتقوقع في زوايا ضيقة مع أبناء بلده. ولا شيء أسوأ من ذلك للعقل، ولا شيء أكثر ضررًا على الحضارة.
فلنتمسك بهذا المبدأ الأساسي: إن الإنسان كائن عاقل وأخلاقي قبل أن يُقيد بلغة معينة، أو يُصنّف في عرق معين، أو يُلحق بثقافة معينة. فقبل الثقافة الفرنسية، أو الألمانية، أو الإيطالية، هناك الثقافة الإنسانية.
انظروا إلى عظماء عصر النهضة؛ لم يكونوا فرنسيين، ولا إيطاليين، ولا ألمانًا. لقد أعادوا، من خلال تواصلهم مع العصور القديمة، اكتشاف السر الحقيقي لتكوين العقل البشري، وكرّسوا حياتهم لذلك بكل إخلاص. وكم كانوا على حق!
III. الدين أيضًا لا يمكن أن يشكل أساسًا كافيًا لتأسيس أمة حديثة.
في الأصل، كان الدين مرتبطًا بوجود الجماعة الاجتماعية نفسها. فالمجموعة الاجتماعية كانت امتدادًا للعائلة، وكانت الطقوس الدينية طقوسًا عائلية. ودين أثينا، على سبيل المثال، كان عبادة لأثينا ذاتها، لمؤسسيها الأسطوريين، لقوانينها، لعاداتها. ولم يكن يحتوي على أي لاهوت عقائدي. كان دين دولة بكل ما للكلمة من معنى. لم يكن الإنسان يُعدّ أثينيًا إذا رفض ممارسة هذا الدين. في جوهره، كان هذا الدين عبادة لأكروبوليس أثينا وكأنها كائن حي. وكان القسم على مذبح أغلاور يعني التعهد بالموت في سبيل الوطن. هذا الدين كان يعادل في زماننا أداء الخدمة العسكرية أو احترام العلم الوطني. ورفض المشاركة فيه كان يُعدّ بمثابة رفض للخدمة الوطنية، أي إعلانًا بأن الشخص ليس من مواطني أثينا.
من ناحية أخرى، من الواضح أن هذا النوع من العبادة لم يكن ذا معنى لمن لم يكن من أثينا؛ ولذلك لم يُمارس أي نوع من التبشير لإجبار الغرباء على قبوله. حتى عبيد أثينا لم يكونوا ملزمين به.
وقد حدث الشيء نفسه في بعض جمهوريات العصور الوسطى الصغيرة. لم يكن الإنسان يُعدّ فينيسيًا جيدًا إن لم يقسم باسم القديس مرقس، ولا أمالفيًا جيدًا إن لم يضع القديس أندراوس فوق كل القديسين الآخرين في الجنة. في تلك المجتمعات الصغيرة، ما أصبح لاحقًا اضطهادًا أو طغيانًا كان يُعدّ شرعيًا، ولا يختلف عن تهنئة ربّ العائلة بعيد رأس السنة أو تقديم الأمنيات له.
ما كان صحيحًا في سبارتا أو أثينا، لم يعد كذلك في الممالك التي نشأت بعد فتوحات الإسكندر، ولا سيما في الإمبراطورية الرومانية. فاضطهاد أنطيوخوس الرابع بهدف فرض عبادة جوبيتر الأولمبي على المشرق، واضطهاد الإمبراطورية الرومانية للحفاظ على ما يُزعم أنها “ديانة الدولة”، كانا خطأً، وجريمة، وحماقة حقيقية.
في زماننا، أصبحت الأمور واضحة تمامًا. لم تعد هناك جماعات تؤمن بطريقة موحدة. كل شخص يؤمن ويمارس كما يشاء، بما يستطيع، وبالطريقة التي يريدها. لم يعد هناك دين للدولة؛ يمكن للمرء أن يكون فرنسيًا، أو إنجليزيًا، أو ألمانيًا، سواء أكان كاثوليكيًا أو بروتستانتيًا أو يهوديًا، أو حتى إن لم يمارس أي دين على الإطلاق.
لقد أصبحت الديانة أمرًا شخصيًا، يخص ضمير كل فرد. ولم تعد هناك تقسيمات قومية على أساس الدين كأن تكون الأمم “كاثوليكية” أو “بروتستانتية”. حتى في بلجيكا، حيث كانت الديانة، قبل اثنين وخمسين عامًا، عنصرًا أساسيًا في تكوين الدولة، فإنها اليوم لا تزال تحظى بأهمية في الحياة الداخلية للأفراد، لكنها اختفت تقريبًا من بين العوامل التي تحدد حدود الشعوب.
IV. إن اشتراك المصالح هو بلا شك رابط قوي بين الناس.
لكن هل يكفي اشتراك المصالح لتكوين أمة؟ لا أعتقد ذلك. فاشتراك المصالح يصنع الاتفاقيات التجارية. أما الأمة، ففيها عنصر شعوري. إنها جسد وروح في آن معًا؛ والاتحاد الجمركي ليس وطنًا.
V. الجغرافيا، أو ما يُعرف بـ”الحدود الطبيعية”، لها بلا شك دور كبير في تقسيم الأمم.
(ويستمر النص…)
… قد يبدو ميتافيزيقيًا بعض الشيء؛ ولكن هذه vérité، من الحقائق الاجتماعية والسياسية، هي من بين الأوضح إن دُرست بعمق.
الترجمة إلى العربية:التاريخ هو العامل الحاسم. لقد وجّهت الأنهار الأعراق البشرية، بينما أوقفتها الجبال. فالأولى سهلت، والثانية حدّت من الحركات التاريخية.
ولكن، هل يمكننا القول، كما تعتقد بعض الأحزاب، إن حدود الأمة مكتوبة على الخريطة، وإن لها الحق في الاستحواذ على ما يلزم من أراضٍ لتسوية بعض الزوايا، أو لبلوغ جبل أو نهر يُمنح نوعًا من القدرة الحدّية المسبقة؟ لا أعرف مذهبًا أكثر تعسفًا وخطورة من هذا. فمن خلاله يُبرَّر كل عنف.
أولًا، هل الجبال أم الأنهار هي التي تُشكل هذه الحدود الطبيعية المزعومة؟
لا شك أن الجبال تفصل، لكن الأنهار توصل بين الشعوب أكثر مما تفصلهم.
ثم، ليست كل الجبال صالحة لتقسيم الدول. فأيها يفصل وأيها لا يفصل؟ من بياريتز إلى تورنيا، لا يوجد مصب نهر واحد يتمتع بطابع حدودي أكثر من غيره.
لو شاء التاريخ، لكانت اللوار، السين، الميز، الإلب، الأودر، لها مثل صفة الحدود الطبيعية التي أُعطيت لنهر الراين، والتي تسببت في كثير من الانتهاكات للحق الأساسي: إرادة البشر.
يُتحدث عن “أسباب استراتيجية”. لا شيء مطلق؛ ومن الواضح أنه لا بد من تقديم بعض التنازلات للضرورة.
لكن لا ينبغي أن تذهب هذه التنازلات بعيدًا جدًا. وإلا فإن الجميع سيطالب بمصالحه العسكرية، وسنعود إلى حرب لا تنتهي.
كلا، فليست الأرض أكثر من العرق ما يصنع أمة.
الأرض تُشكل الأساس، ساحة الكفاح والعمل؛ أما الإنسان فيُشكل الروح. الإنسان هو كل شيء في تكوين هذه الظاهرة المقدسة التي تُدعى الشعب.
لا شيء مادي يكفي لذلك.
فالأمة مبدأ روحي، ناتج عن تعقيدات التاريخ العميقة، وهي أسرة روحية، لا مجموعة يُحددها شكل الأرض.
لقد رأينا لتوّنا ما لا يكفي لتكوين مثل هذا المبدأ الروحي: العرق، اللغة، المصالح، القرابة الدينية، الجغرافيا، الضرورات العسكرية.
فما الذي يلزم إذًا؟ بناءً على ما قيل سابقًا، لن أُطيل في شرح ذلك.
III. الأمة روح، مبدأ روحي.
هناك شيئان — يشكلان في الحقيقة شيئًا واحدًا — يُكوّنان هذه الروح، هذا المبدأ الروحي:
أحدهما في الماضي، والآخر في الحاضر.
الأول هو الامتلاك المشترك لإرث غني من الذكريات؛
والثاني هو التوافق الحالي، والرغبة في العيش معًا، والإرادة في مواصلة استثمار الإرث الذي ورثناه دون تقسيم.
فالإنسان، يا سادتي، لا يُصنَع صدفة.
الأمة، مثل الفرد، هي حصيلة ماضٍ طويل من الجهود، والتضحيات، والإخلاص.
إن عبادة الأجداد هي أصدق العبادات، لأن الأجداد هم من جعلونا ما نحن عليه.
ماضٍ بطولي، رجال عظام، مجد (وأعني المجد الحقيقي) — هذه هي الثروة الاجتماعية التي تُبنى عليها الفكرة الوطنية.
أن يكون لنا مجد مشترك في الماضي، وإرادة مشتركة في الحاضر؛
أن نكون قد أنجزنا أعمالًا عظيمة معًا، ونرغب في إنجاز أخرى — هذه هي الشروط الأساسية لكي نكون شعبًا.
نحن نحب بقدر ما ضحّينا، وما عانينا.
نحن نحب البيت الذي بنيناه ونورثه.
النشيد الإسبرطي: «نحن ما كنتم أنتم؛ وسنكون ما أنتم عليه» هو، ببساطته، النشيد المختصر لكل وطن.
في الماضي: إرث من المجد والأسى نتشاركه؛
في المستقبل: برنامج مشترك نُنجزه.
أن نكون قد تألمنا، وفرحنا، وأمِلنا معًا — هذا أفضل بكثير من حدود جمركية مشتركة، أو حدود مرسومة وفق مصالح استراتيجية.
هذا ما يُفهَم رغم اختلاف الأعراق واللغات.
قلت قبل قليل: أن نكون قد تألمنا معًا — نعم، فالمعاناة المشتركة توحد أكثر من الفرح.
في ما يخص الذكريات الوطنية، فإن الأحزان أفضل من الانتصارات، لأنها تفرض واجبات، وتدفع إلى الجهد الجماعي.
إذًا، فالأمة هي تضامن عظيم، يتكوَّن من الإحساس بالتضحيات التي قدمناها، والتي نحن مستعدون لتقديمها مجددًا.
إنها تفترض ماضيًا؛ لكنها تختصر في الحاضر بفعل ملموس: التوافق، والرغبة المعلنة في مواصلة الحياة المشتركة.
وجود الأمة هو — اسمحوا لي بهذه الاستعارة — استفتاء يومي دائم، تمامًا كما أن وجود الفرد هو تأكيد دائم على الحياة.
أوه! أعلم أن هذا…
.. هو أقل ميتافيزيقية من الحق الإلهي، وأقل وحشية من ما يُسمى بـ”الحق التاريخي”.
في السياق الفكري الذي أقدمه لكم، ليست للأمة، أكثر مما للملك، أي حق في أن تقول لإحدى المقاطعات: «أنتِ لي، سأستولي عليكِ».
المقاطعة، بالنسبة لنا، تعني سكانها؛ وإذا كان هناك من يحق له أن يُستشار في هذا الشأن، فهو السكان.
فلا مصلحة حقيقية لأمة في ضمّ بلد أو الاحتفاظ به رغمًا عنه.
رغبة الشعوب، في نهاية المطاف، هي المعيار الشرعي الوحيد، وهي التي يجب الرجوع إليها دومًا.
لقد طردنا من السياسة التجريدات الميتافيزيقية واللاهوتية؛
فماذا بقي بعد ذلك؟
بقي الإنسان، برغباته واحتياجاته.
قد تقولون لي: الانفصال، بل وتفتت الأمم على المدى الطويل، هو نتيجة نظام يضع هذه الكيانات القديمة تحت رحمة إرادات في الغالب غير مدروسة.
من الواضح أن أي مبدأ في هذا المجال لا يجب تطبيقه إلى أقصى حد.
فالحقائق من هذا النوع لا تُطبَّق إلا بشكل عام وشامل.
الإرادات البشرية تتغيّر؛ ولكن، ما الذي لا يتغيّر في هذا العالم؟
الأمم ليست أبدية؛ لقد بدأت، وستنتهي.
وغالبًا ما ستحل محلها الكونفدرالية الأوروبية.
لكن هذه ليست قانون العصر الذي نعيش فيه.
في الوقت الحاضر، وجود الأمم أمر جيد، بل ضروري.
وجودها هو ضمانة الحرية، تلك التي ستضيع لو كان العالم يخضع لقانون واحد ولسيّد واحد.
بفضل قدراتها المختلفة، وغالبًا المتعارضة، تساهم الأمم في العمل المشترك للحضارة؛
فكل أمة تضيف نغمةً إلى هذا الحفل الكبير للإنسانية،
الذي هو، في نهاية المطاف، أسمى واقع مثالي يمكننا بلوغه.
معزولة، تُظهر كل أمة نقاط ضعفها.
كثيرًا ما أقول لنفسي: لو وُجد فردٌ يتحلّى بالعيوب التي تُعتبر فضائل لدى الأمم — يتغذى على المجد الزائف، غيور، أناني، عدواني، لا يحتمل شيئًا دون أن يشهر سيفه — لكان هذا الفرد من أشد الناس إزعاجًا.
لكن هذه النشازات الفردية تتلاشى في الكل.
أيتها الإنسانية البائسة، كم عانيتِ! وكم من المحن لا تزال في انتظارك!
ليُرشدكِ روح الحكمة، ليحفظكِ من المخاطر الكثيرة التي تعترض طريقكِ!
أُجمل القول، سادتي:
الإنسان ليس عبدًا لا لعرقه، ولا لغته، ولا لدينه، ولا لمجرى الأنهار، ولا لاتجاه سلاسل الجبال.
تكتل كبير من البشر، يتمتع بالعقل السليم وبالدفء العاطفي، يُنتج وعيًا أخلاقيًا يُسمى أمة.
وطالما أن هذا الوعي الأخلاقي يُثبت قوته من خلال التضحيات التي يقتضيها تنازل الفرد لصالح الجماعة، فهو مشروع، وله الحق في الوجود.
وإذا نشأ خلاف حول حدودها، فلتُستشَر الشعوب المعنية.
فلها كامل الحق في إبداء الرأي.
هذا ما سيجعل “السامين في السياسة” يبتسمون بسخرية — هؤلاء المعصومون الذين يقضون حياتهم في الخطأ، والذين، من علُو مبادئهم العليا، ينظرون بازدراء إلى واقعنا البسيط.
«استشارة الشعوب؟ يا للبساطة!
ها هي الأفكار الفرنسية التافهة تحاول أن تحل محل الدبلوماسية والحرب بوسائل طفولية!»
دعونا ننتظر، سادتي؛
لندع عهد المتعالين يمر؛
ولنتقبل احتقار الأقوياء.
فلعلنا، بعد كثير من العثرات غير المجدية، نعود إلى حلولنا المتواضعة والتجريبية.
فأفضل وسيلة لأن تكون على صواب في المستقبل، هي أن تعرف — في لحظات معينة — كيف تتحمّل أن تُعتبر قديم الطراز