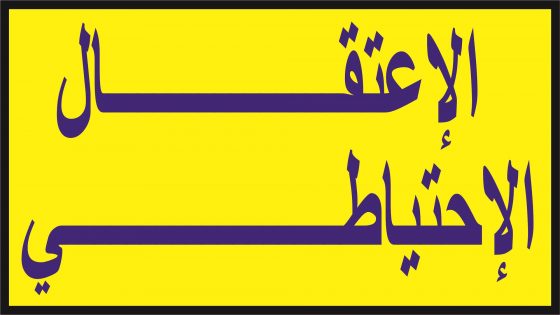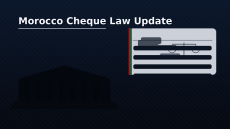كيف تُنظّم إضرابك قانونياً في المغرب؟
مقدّمة: لماذا هذا القانون الآن؟
بعد أكثر من نصف قرن من انتظار إطارٍ واضح، دخل القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حقّ الإضراب حيّز التنفيذ ابتداءً من 24 شتنبر 2025، عقب نشره بالجريدة الرسمية (العدد 7389 بتاريخ 24 مارس 2025) وما نصّت عليه مادته الأخيرة من أجلٍ انتقالي. بذلك انتقل المغرب من منطقةٍ رماديةٍ كان يُمارَس فيها الإضراب على أساس مبادئ عامة واجتهادات متباينة، إلى قواعد دقيقة تُوازن بين حقوق العمال وحرية العمل واستمرارية المرافق والخدمات الأساسية. هذا التحوّل يطرح إشكالية مركزية: كيف نوفّق بين حماية الحقّ الدستوري في الإضراب وضمان السير العادي للاقتصاد والمرافق الحيوية؟ الجواب تحاول هذه المقالة أن تقدّمه بشكلٍ عملي: ما الذي جاء به القانون، من يملك حقّ الدعوة، ما الإجراءات والآجال، وما هي حدود المسؤوليات والعقوبات؟
المحور الأول: ماهية الحق ومجاله… وما الذي تغيّر فعلاً؟
يُقرّر القانون منذ مادته الأولى أن الإضراب حقّ دستوري تحميه مبادئ حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية المصادق عليها، وكلّ تنازلٍ عنه باطل. ويقدّم تعريفاً دقيقاً للإضراب باعتباره توقّفاً مؤقتاً كلّياً أو جزئياً عن العمل، تتّخذه جهةٌ داعيةٌ وفق شروط القانون، دفاعاً عن حقّ أو مصلحةٍ اجتماعية/اقتصادية/مهنية مرتبطة بظروف العمل أو ممارسة المهنة. كما يوسّع مجال التطبيق ليشمل القطاعين العام والخاص، والمهنيين، والعمّال المنزليين، والعمّال غير الأجراء وفق ما يحدّده التشريع الجاري به العمل. الأهمّ أن القانون يضع مبدأين متلازمين: ضمان ممارسة الإضراب، وضمان حرية العمل للغير ومنع أيّ فعلٍ يعرقلها أو يحتلّ أماكن العمل. هذه الركائز تُنهي حالة الغموض وتُرسي توازناً بين أطراف علاقة الشغل.
على المستوى المؤسساتي، سبقت دخول القانون مرحلةٌ تشريعية وقضائية مهمّة: المصادقة البرلمانية في فبراير 2025، ثم قرار المحكمة الدستورية في 12 مارس 2025 الذي صرّح بمطابقة النصّ للدستور مع ملاحظات تخصّ بعض المواد، قبل أن يُنفّذ بموجب الظهير الشريف ويُنشر بالجريدة الرسمية. هذا المسار يعزّز شرعية الإطار الجديد ويمنح الفاعلين سنداً قانونياً صلباً.
المحور الثاني: من يملك حقّ الدعوة إلى الإضراب؟ وكيف تُتَّخذُ القرارات داخلياً؟
يُميّز القانون بين مستويات الدعوة: وطنية، قطاعية، على مستوى مرفقٍ عمومي، أو داخل مقاولة/مؤسسة. في المستويين الوطني والقطاعي، تملك الدعوةَ المنظمات النقابية الأكثر تمثيلية أو النقابات ذات التمثيلية. أمّا داخل المقاولة/المؤسسة، فيُجيز القانون أيضاً لجنة الإضراب –بضوابط– أن تدعو إلى الإضراب. وتُحدّد المادة 11 الجهات المخوّلة بحسب كلّ مستوى بشكلٍ حاصِر، حتى لا تتحوّل الدعوة إلى فعلٍ بلا حاملٍ قانوني
ولأن القرار الجماعي يحتاج شرعيةً داخليةً واضحة، تُفصّل المادة 12 شروط الدعوة داخل المقاولة/المؤسسة:
• تحرير محضر يوقّعه ما لا يقلّ عن 25% من الأجراء يوافقون فيه على الدعوة، ويُعيّنون لجنة الإضراب في حدود ستة أعضاء كحدّ أقصى.
• انعقاد جمعٍ عام صحيح بحضور ما لا يقلّ عن 35% من الأجراء.
هنا تتجلّى فلسفة النصّ: لا يكفي أن تكون هناك رغبةٌ في الإضراب، بل لا بدّ من تمثيلٍ حقيقي وإجراءاتٍ تضمن أن القرار جماعيّ ومدروس.
المحور الثالث: الشروط والإجراءات والآجال… طريق الإضراب المشروع
1) قبل الدعوة: مسطرة التفاوض والانتظار الإلزامي
يميّز القانون بين الإضراب المرتبط بملف مطلبي والإضراب المرتبط بـقضايا خلافية (نزاعات ناشئة بسبب الشغل أو الإخلال بالالتزامات).
• في الملف المطلبي:
o على الصعيد الوطني: انتظار 45 يوماً مع إمكان تمديدٍ واحد لمدّة 15 يوماً بطلب أحد الأطراف.
o على مستوى المرفق العمومي/القطاع الخاص/المقاولة: انتظار 15 يوماً مع إمكان تمديدٍ واحد لمدّة 15 يوماً.
• في القضايا الخلافية:
o على الصعيد الوطني: انتظار 30 يوماً.
o على مستوى المرفق العمومي/القطاع الخاص/المقاولة: انتظار 7 أيام (وفق طبيعة النزاع وسير المساعي).
هذه الآجال تُحتسب من تاريخ التوصّل بالملف أو إخطار الخلاف، وتُراد بها إتاحة فرصةٍ حقيقية للتسوية والحوار قبل اللجوء إلى الإضراب
2) قرار الإضراب ومحتوياته الإلزامية
ينصّ القانون على بياناتٍ يجب تضمينها في القرار: اسم الجهة الداعية، سبب الإضراب، أماكن العمل المعنيّة، والجداول الزمنية (التاريخ/الساعة بدءاً وانتهاءً)، مع إرفاق نسخة من الملف المطلبي أو القضايا الخلافية وما يثبت خطر المسّ بصحّة وسلامة الأجراء أو المرفق عند الاقتضاء. الهدف أن يكون القرار شفّافاً وقابلاً للمساءلة أمام الإدارة والعمّال والرأي العام
3) الإخطار المسبق: لمن؟ ومتى؟
يلزم القانون بإخطار مسبق قبل التنفيذ، يختلف بحسب المستوى:
• سبعة (7) أيام على الأقل عند الإضراب الوطني: يُوجَّه إلى رئيس الحكومة والسلطات الحكومية المعنية والداخلية.
• خمسة (5) أيام على الأقل عند الإضراب على المستوى الترابي/المرفق العمومي/المقاولة: يُوجَّه إلى العامل/الوالي أو ممثّل السلطة الحكومية المختصة، وكذلك إلى المشغّل في القطاع الخاص.
بهذا يصير الإخطار آليةً لإدارة المخاطر والتأهّب، لا مجرّد ورقة شكلية
4) أثناء الإضراب: واجبات وتدابير تنظيمية
تتولّى الجهة الداعية تأطير المضربين، وتأمين السلم داخل أماكن العمل، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الصحّة والسلامة المهنية وحماية الممتلكات ومنع الاعتداءات أو تعطيل المرافق بما يفوق حدود ممارسة الحق. كما يُجيز القانون تعليق الإضراب مؤقتاً للتفاوض ثم استئنافه بخصوص نفس الدواعي دون التقيد بآجال جديدة، ما دامت مسطرة التعليق قد روعيت
المحور الرابع: الخدمات الدنيا، والفئات المستثناة، وحدود المشغّل
الخدمات الدنيا (الحد الأدنى)
يلزم القانون بتوفير حدٍّ أدنى من الخدمة في مرافق وقطاعات حيوية، من أبرزها: المؤسسات الصحية، المحاكم، بنك المغرب، الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، نشر الجريدة الرسمية، الأرصاد الجوية، النقل السككي والبري والبحري والجوي، الاتصال السمعي البصري العمومي والاتصالات، صناعة وتوزيع الأدوية والأوكسجين الطبي، الوقاية الصحية بالحدود والمطارات والموانئ، المصالح البيطرية، إنتاج وتوزيع الماء والكهرباء والطاقات، والتطهير وجمع النفايات. ويشترط أن يُحدَّد هذا الحدّ الأدنى بما يكفل استمرارية الخدمات الأساسية مع الحفاظ على حق المضربين في ممارسة حقّهم بحدوده المشروعة. وتجدر الإشارة إلى أنّ التطبيق العملي الكامل لهذا المقتضى ينتظر بعض النصوص التنظيمية التفصيلية
الفئات المستثناة من ممارسة الإضراب
استبعد القانون ممارسة الإضراب من قبل فئاتٍ معيّنة بحكم طبيعة مهامها، وفي مقدّمتها: موظفو إدارة الدفاع الوطني والعسكريون وأفراد القوة العمومية وضباط الشرطة القضائية وبعض الفئات ذات الطابع السيادي أو الأمني/الدبلوماسي، إلى جانب العمّال المكلّفين بتأمين الأنشطة الضرورية أثناء سريان الإضراب لفترة التكليف. كما حظر إحلال عمّالٍ جدد مكان المضربين أو نقل الآليات ووسائل العمل خلال الإضراب. هذه القيود تعكس أولوية الأمن والخدمة العامة دون نفيِ الحقّ في الإضراب عن باقي الفئات.
حدود المشغّل
من جهة المشغّل، يُحظر الإغلاق الكلّي أو الجزئي للمقاولة خلال سريان الإضراب (Lockout) إلا وفق شروطٍ قضائيةٍ صارمة عند وجود خطرٍ جسيم على السلامة/الممتلكات، مع التزامٍ مسبقٍ بمساطر قانونية. كما لا يجوز استعمال الإضراب المشروع ذريعةً للفصل التأديبي أو العزل، ولا اتخاذ إجراءاتٍ تمييزية ضدّ المضربين. بالمقابل، يُعتبر المشارك في الإضراب في حالة توقفٍ مؤقّت عن العمل غير مؤدّى عنه أجر. هكذا يتوازن الحقّ مع الواجبات المالية والتنظيمية للطرفين.
المحور الخامس: المخاطر القانونية والعقوبات… وكيف تتجنّبها عملياً
يُخصّص القانون باباً كاملاً للجزاءات لحماية حرية الإضراب وحرية العمل في آنٍ معاً، ومن أبرزها:
• غرامات من 10.000 إلى 50.000 درهم على كلّ من دعا إلى ممارسة حقّ الإضراب من دون التقيد بالمقتضيات الجوهرية (المواد 11، 13، 14 وفقرة من 17).
• غرامات من 15.000 إلى 30.000 درهم عند عرقلة حرية العمل أو خرق الضمانات المرتبطة بها.
• غرامات من 20.000 إلى 50.000 درهم عند إحلال عمّالٍ مكان المضربين أو خرق مقتضيات الحد الأدنى للخدمة.
• غرامات من 1.200 إلى 8.000 درهم عند رفض القيام بالأنشطة الضرورية المكلَّف بها العامل لتأمين السلامة والخدمة الدنيا.
كما ينصّ على مضاعفة الغرامة بعدد الأجراء المتضرّرين في بعض المخالفات، وعلى توثيق المخالفات بمحاضر الشرطة القضائية وإحالتها على النيابة العامة. هذه المنظومة لا تهدف إلى التضييق على الحق، بل إلى ردع التجاوزات وضمان الضبط القانوني للحركات الاجتماعية.
كيف تُنظّم إضرابك قانونياً؟ (دليل عملي موجز)1. اختيار الجهة الداعية:
إن كان الإضراب وطنياً/قطاعياً فالمخاطَب هي النقابة الأكثر تمثيلية أو ذات التمثيلية. داخل المؤسسة، أعدّ لوجستياً لجنة الإضراب وفق المادة 12 بمحضرٍ صحيح (توقيع ≥25%، وجمع عام بحضور ≥35%).
2. تحديد الطبيعة القانونية:
هل الأمر ملفّ مطلبي أم قضية خلافية؟ سيُغيّر هذا من آجال الانتظار قبل الدعوة (45/15 يوماً للأول حسب المستوى، و30/7 أيام للثاني). لا تُعلن أيّ تواريخ قبل استيفاء الآجال.
3. صياغة قرار الإضراب:
تضمين البيانات الإلزامية (الجهة الداعية، الأسباب، الأماكن، الجداول الزمنية)، وإرفاق الوثائق (ملف مطلبي/قضية خلافية/ما يثبت مخاطر السلامة عند الاقتضاء
4. الإخطار في الآجال:
سبعة أيام وطنياً، وخمسة أيام ترابياً/مؤسساتياً، مع توجيه الإشعار للسلطات المحدّدة قانوناً وللمشغّل في القطاع الخاص. احتفِظ بإثباتات التبليغ
5. الخدمات الدنيا والسلامة:
حدّدوا مسبقاً ترتيبات الحدّ الأدنى من الخدمة بقطاعاتكم (عند الاقتضاء)، وخطّة السلامة ومنع الإتلاف أو الاعتداء. هذه النقطة حسّاسة قانونياً وإعلامياً.
6. التأطير والتواصل:
عيّنوا ناطقاً/لجنةً للتفاوض، سجّلوا محاضر الاجتماعات، وابقوا منفتحين على تعليقٍ مؤقّت بغرض التفاوض مع حفظ الحقّ في الاستئناف لنفس الدواعي دون آجالٍ جديدة عند احترام المسطرة.
7. تجنّب المخالفات الشائعة:
لا تُبدؤوا الإضراب قبل استيفاء الآجال والإخطار، لا تُعيقوا حرية غير المضربين أو تحتلّوا أماكن العمل، ولا تسمحوا بأيّ إحلالٍ لعمّالٍ محلّ المضربين أو نقلٍ للآليات خلال الإضراب، وتفادَوا إغلاقاً كلياً/جزئياً من طرف المشغّل خارج المساطر. هذه النقاط هي الأكثر تعرّضاً للغرامات
معلومة مهمّة للتنزيل: رغم دخول القانون حيّز التنفيذ، نبّهت تقارير صحفية اقتصادية إلى أنّ فعاليته الكاملة ستتأثّر بصدور بعض النصوص التنظيمية المكمّلة (خصوصاً في تنظيم الحدّ الأدنى من الخدمة بالتفصيل القطاعي). متابعة هذه النصوص ضرورة لتفادي فراغات تطبيقية
أسئلةٌ وسياقات محيطة تعني الفاعلين
• ما موقع النقابات؟ يمنحها القانون دوراً محورياً في الدعوة والإخطار والتأطير، مع فتح المجال داخل المؤسسة للّجان المنتخبة بشروط. هذا يعيد الاعتبار لـالتمثيلية كمدخلٍ للشرعية.
• هل هناك توازنٌ حقيقي؟ اعتبر فاعلون اقتصاديون أنّ النصّ “متوازن” لأنه يحمي حقّ الإضراب وفي الآن نفسه يضمن حرية العمل ويصون المقاولة من التعطيل الشامل، وهو ما يحدّ من الكلفة الاقتصادية ويشجّع الحلول التوافقية. من جهةٍ أخرى، أثارت منظمات حقوقية ونقابية ملاحظاتٍ بخصوص بعض القيود والقطاعات المستثناة، ما يعني أنّ النقاش العمومي حول التنزيل سيستمرّ
• إطارٌ محلّ متابعة إعلامية واسعة: دخول القانون حيّز التنفيذ لقي تغطيةً واسعة في الصحافة الوطنية (منها هسبريس) لما له من أثر مباشر على نزاعات الشغل، وسلوك الاحتجاج، واستمرارية الخدمات
خاتمة: بين الحقّ والمسؤولية… نحو ثقافةٍ جديدة للاحتجاج الاجتماعي
جمع قانون الإضراب 97.15 بين تثبيت الحقّ الدستوري وتجريم التجاوزات التي تعرقل حرية العمل أو تعرّض سلامة الأشخاص والممتلكات للخطر، وحدّد بوضوح من يملك الدعوة، وما الآجال، وكيف تُدار المراحل من الدعوة إلى التعليق والاستئناف. النجاح الحقيقي لهذا القانون لن يُقاس فقط بعدد الإضرابات “القانونية”، بل بقدرة الفاعلين على استباق النزاعات عبر حوارٍ فعّال، وبحسن تنزيل الخدمات الدنيا دون مسّ بجوهر الحقّ. يبقى السؤال المفتوح: كيف سنحوّل هذا الإطار الجديد إلى ثقافة مؤسسية للتفاوض والاحتجاج المسؤول تُقلّل كلفة النزاعات وتُعظّم المكاسب الاجتماعية؟