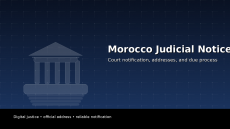يعتبر حق الشفعة من أعرق النظم القانونية التي تهدف إلى الحد من تفتيت الملكية المشاعة وضبط استقرار المعاملات العقارية، إذ منح المشرع الشريك في العقار المشاع أولوية شراء الحصة المبيعة لغيره من الشركاء، درءا لدخول الغير في الملكية على نحو قد يضر بالانسجام أو يعرقل الاستغلال، وقد استمد المشرع المغربي أحكام الشفعة من الفقه المالكي الذي أولاها أهمية كبرى، ثم كرسها ضمن قانون الالتزامات والعقود ولاحقا ضمن قانون 39.08 المتعلق بالحقوق العينية، مما يؤكد استمرار أهميتها في المنظومة العقارية المغربية.
إلا أن تطور المعاملات العقارية في ظل انتشار التمويل البنكي أفرز تحديات جديدة أمام ممارسة هذا الحق، حيث أضحت معظم عمليات البيع العقاري تتم عبر قروض بنكية مضمونة برهون رسمية، مما يؤدي إلى تعقيد العلاقة بين المشتري من جهة، والبنك الدائن المرتهن من جهة ثانية، والشفيع الذي يرغب في الحلول محل المشتري من جهة ثالثة.
وهنا يثور الإشكال الجوهري، هل يجوز للشفيع تجزئة عرض ثمن الشفعة بين المشتري والبنك المرتهن، أم أن مقتضيات القانون توجب أداء الثمن كاملا للمشتري وحده؟ هذا التساؤل يطرح بدوره أسئلة فرعية، تتعلق بالإطار القانوني الناظم لعرض ثمن الشفعة في التشريع المغربي، وكيف عالج القضاء المغربي وخاصة محكمة النقض، مسألة تجزئة العرض؟
للإجابة عن هذه التساؤلات، سنتناول الموضوع وفق ثلاثة فقرات:
الأساس القانوني لعرض الثمن (الفقرة الأولى)، ثم بيان موقف القضاء المغربي حول مدى إمكانية تجزيئ العرض (الفقرة الثانية)، وأخيرا مقاربة توفيقية بين الحقين (الفقرة الثالثة)، على أن نختم مقالنا باستخلاص أهم النتائج والتوصيات المتعلقة بالموضوع.
الفقرة الأولى: الأساس القانوني لعرض ثمن الشفعة
النقطة الأولى: مبدأ التطابق والتمامية في العرض
أوجب المشرع المغربي على من يريد الأخذ بالشفعة أن يؤدي الثمن الحقيقي الذي انعقد به البيع بجميع مصاريفه وملحقاته. فقد نص الفصل 974 من قانون الالتزامات والعقود على أنه: «من يريد الأخذ بالشفعة عليه أن يدفع الثمن الحقيقي الذي وقع به البيع مع المصاريف اللازمة…». وهو نص صريح يلزم الشفيع بالتطابق التام بين الثمن المعروض وبين الثمن المؤدى في عقد البيع،
ويفهم من هذا المقتضى أن العرض يجب أن يكون كاملا، فوريا، وموحدا، أي غير قابل للتجزئة أو التبعيض. فمتى قدم العرض ناقصا، سواء من حيث المبلغ أو من حيث الجهة المستحقة له، سقط الحق في الشفعة، وتقوم هذه القاعدة على أساس فقهي راسخ في الفقه المالكي، الذي اشترط على الشفيع أن «يعرض مثل ما دفع المشتري للبائع» دون نقصان أو اختلاف.
الفرع الثاني: الالتزام بأداء كامل الثمن ومصير العروض الناقصة
أكدت محكمة النقض مرارا أن العرض الناقص أو غير المطابق لا يرتب أي أثر، فقد قضت في قرارها عدد 451 بتاريخ 11 ماي 2005 (ملف مدني عدد 3245/1/1/2003) بأن:
«العرض الذي لا يطابق الثمن الحقيقي المصرح به في عقد البيع يعد عرضا غير صحيح، ويترتب عنه سقوط الحق في الشفعة».
كما جاء في قرارها عدد 1528 بتاريخ 14 دجنبر 2010 (ملف مدني عدد 2829/1/1/2008) أن: «تجزئة العرض بين المشتري وغيره لا يحقق شرط التطابق، مما يترتب عنه عدم قبول دعوى الشفعة».
يتضح إذن أن الأصل القانوني والقضائي معًا يكرس وجوب وحدة العرض وكماله، وهو ما يجعل أي تجزئة تُعتبر انحرافًا عن المبدأ.
الفرع الثالث: الطبيعة القانونية للثمن المرهون
في حالات البيع المثقل برهن رسمي، يتخذ جزء من الثمن شكل قرض بنكي مضمون بالرهن. هذا الجزء لا يستوفيه البائع مباشرة، بل يبقى مدينًا به المشتري تجاه البنك. هنا يثور الخلط بين مفهوم «الثمن» كمقابل للبيع، و«الدين البنكي» كالتزام شخصي للمشتري. وبما أن الشفيع لا يخلف المشتري في التزاماته الشخصية تجاه البنك، وإنما فقط في مركزه العيني على العقار، فإن مقتضيات القانون توجب أن يظل العرض موجها للمشتري لا للبنك، إلا إذا نص العقد صراحة على غير ذلك.
الفقرة الثانية: موقف القضاء المغربي من تجزئة عرض الثمن
النقطة الأولى: الاتجاه القضائي الرافض للتجزئة
استقر قضاء محكمة النقض على رفض كل محاولة لتجزئة العرض، معتبرًا أن التزام الشفيع هو تجاه المشتري حصرا. والعلّة في ذلك أن البنك المرتهن ليس طرفا في عقد البيع، وإنما هو صاحب حق عيني تبعي مستقل، وبالتالي لا شأن للشفيع بعلاقته مع المشتري.
وهذا التوجه يعكس نزعة شكلية صارمة، تروم حماية استقرار المعاملات وتفادي تشعب الخصومات.
النقطة الثانية: الاتجاه القضائي المرن
رغم هيمنة الاتجاه الأول، برزت بعض القرارات على مستوى محاكم الاستئناف تنحو منحى مغايرا، حيث قبلت العرض المزدوج إذا نص عقد البيع على تخصيص جزء من الثمن لأداء الدين البنكي. فقد اعتبرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء (ملف 189/2009) أن: )التشدد في رفض العرض المزدوج رغم التنصيص عليه في العقد يُعد إهدارا لحق الشفيع وإضرارا بمصالح البنك، بينما القبول به يحقق العدالة ويوازن بين المصالح(.
ورغم وجاهة هذا التعليل، إلا أنه لم يحظ بتكريس على مستوى محكمة النقض، مما أبقاه في دائرة الاجتهادات المحدودة.
النقطة الثالثة: المقارنة مع اجتهادات عربية
في القانون المصري، سمح القضاء للشفيع أن يوجه جزءا من الثمن للبائع والجزء الآخر للجهة الممولة إذا كان العقد ينص على ذلك صراحة، مراعاة للواقع العملي للعقارات المرهونة، أما في تونس، فإن المجلة العقارية تلزم الشفيع بأداء الثمن كاملا للبائع، دون إمكانية للتجزئة، شأنها شأن الموقف المغربي.
هذه المقارنة تظهر أن التشدد ليس خاصية مغربية فقط، وإنما هو توجه سائد في التشريعات المغاربية، مقابل مرونة نسبية في بعض الأنظمة المشرقية.
الفقرة الثالثة: نحو مقاربة توفيقية بين حق الشفعة وضمانات الدائن المرتهن
النقطة الأولى: قصور النص الحالي أمام واقع الرهن البنكي
النصوص الحالية لم تستوعب بعدُ واقع المعاملات العقارية الحديثة التي تعتمد كليا على التمويل البنكي. فالإصرار على وحدة العرض دون مرونة يفرغ حق الشفعة من محتواه، لأن الشفيع قد يجد نفسه مضطرا لأداء مبالغ تفوق قيمة الحصة فعليا، في حين يظل البنك متمسكا بحقوقه مستقلة عن ذلك.
النقطة الثانية: الحلول العملية الممكنة
من بين الحلول التي يقترحها الفقه إلزام الموثقين بإدراج البنك كطرف في عقد البيع حينما يكون هناك قرض عقاري، مما يجعل من الجائز للشفيع أداء الجزء الممول للبنك مباشرة، وكذا السماح للشفيع بأن يؤدي الثمن كاملا للمشتري، مع تمكين هذا الأخير من تسوية دينه البنكي مباشرة، وهو حل يحافظ على وحدة العرض، لكنه يثقل كاهل الشفيع.
النقطة الثالثة: المقترحات التشريعية والفقهية
لتجاوز الإشكال، نقترح تعديل قانون 39.08 المتعلق بالحقوق العينية للتنصيص صراحة على جواز توجيه جزء من عرض الشفعة للدائن المرتهن إذا كان العقد يتضمن ذلك، الى جانب تطوير اجتهاد محكمة النقض نحو المرونة في الحالات التي يظهر فيها حسن نية الشفيع ووضوح العقد، وذلك باستلهام التجربة المصرية في التوفيق بين الحقين، مع تكييفها وفق خصوصية النظام العقاري المغربي، حيث أن الواقع العملي للعقارات الممولة بالرهن البنكي يفرض مراجعة هذا الموقف، إذ أن إصرار القضاء على الصرامة قد يؤدي إلى إفراغ الشفعة من غاياتها الحمائية.لذلك فإن الحل الأمثل يكمن في تبني مقاربة توفيقية تراعي مصالح جميع الأطراف: الشفيع، المشتري، والبنك المرتهن. ويكون ذلك إما عبر اجتهاد قضائي أكثر مرونة يقبل العرض المزدوج متى نص العقد صراحة على ذلك، أو عبر تدخل تشريعي يضمن التنصيص الواضح على كيفية التعامل مع الثمن المرهون.